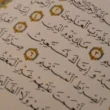مقدمة عن علم الصرف
يعتبر علم الصرف من العلوم اللغوية الهامة التي تهتم بدراسة الكلمة العربية، وكيفية بنائها وصياغتها. يُعرّف علم الصرف بأنه العلم الذي يختص بمعرفة كيفية تشكيل الكلمات، ودراسة حالتها من حيث البناء والإعراب. الأصل في هذا العلم هو البحث عن جذر الكلمة، والذي يعتبر الأساس المشترك بين مجموعة من الكلمات التي تنتمي إلى أصل واحد. [1]
قد تطرأ بعض التغييرات على بنية الكلمة، سواء كان ذلك لسبب معنوي أو لسبب لفظي، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
- التغيير في بنية الكلمة لسبب معنوي: هذا النوع من التغيير يهدف إلى تحويل الكلمة من صيغة المفرد إلى المثنى أو الجمع، أو لتصغير الكلمة، أو للنسب، أو للاشتقاق من المصدر أو الفعل. نلاحظ أن الكلمة بعد هذا التغيير تكتسب معنى إضافيًا.
- التغيير في بنية الكلمة لسبب لفظي: يشمل هذا النوع من التغيير أمورًا مثل الإدغام، والإعلال، والإبدال، والقلب، والنقل، والحذف. يهدف هذا التغيير إلى تسهيل النطق وتجنب ثقل الأصوات، وتحقيق الانسجام الصوتي.
نطاق علم الصرف
يختص علم الصرف بدراسة الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة. أما الأسماء المبنية (مثل الضمائر، والأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط المبنية، وأسماء الأفعال)، والحروف (مثل حروف العطف، والجر، والنصب، والجزم)، والأفعال الجامدة (مثل “بئس”، و “عسى”، و “ليس”)، فهي لا تدخل ضمن نطاق بحث علم الصرف.
أهم فروع علم الصرف
يضع علم الصرف قواعد محددة لعدد من الفروع، ومن أهمها: [2]
-
الميزان الصرفي: هو مقياس يستخدم لمعرفة بنية الكلمة. يعتمد الميزان الصرفي على الحروف (ف، ع، ل) كأصل للكلمة، حيث أن معظم الكلمات العربية تتكون من ثلاثة أحرف أصلية. أي زيادة في الكلمة تقابلها زيادة في الميزان، وأي نقص يقابله نقص في الميزان. على سبيل المثال:
- درس: فعل
- دارس: فاعل
- دعا: فعل
- لم يدعُ: لم يفعُ
-
الاشتقاق وأنواعه: هو توليد صيغ جديدة من أصل واحد، ولكل صيغة دلالة معينة. الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. أنواع المشتقات:
- اسم الفاعل (مثل: قارئ، مقدّم).
- اسم المفعول (مثل: مقروء، مقدَّم).
- الصفة المشبهة (مثل: أعمى، عطشان).
- صيغة المبالغة (مثل: قوّال، صدوق).
- اسم التفضيل (مثل: أكبر، كبرى).
- اسم المكان والزمان (مثل: مَكتب، مَطلع).
- اسم الآلة (مثل: حاسوب، ثلاّجة).
- النسب: إضافة ياء النسب إلى الاسم ليدل على الانتساب إليه. على سبيل المثال: “مصريّ” (نسبة إلى مصر)، “كهربائيّ” (نسبة إلى الكهرباء).
- التصغير: تصغير الأسماء للدلالة على التحقير أو التحبب أو التقريب. أمثلة: دُبيب، بُعيد، شُويعر، أُصيحاب.
- الزيادة ومعانيها: إضافة حروف زائدة إلى بنية الكلمة الأصلية، مما يضيف معنى جديدًا. الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. مثال: الفعل “كرُم” (على وزن “فعل”) يدل على حدوث الكرم في الزمن الماضي. إذا تم تضعيف الراء (كرّم)، فإن الكلمة تكتسب معنى جديدًا وهو المبالغة.
-
التذكير والتأنيث والتثنية والجمع: تطبيق قواعد التذكير والتأنيث على الأسماء والأفعال بعلامات محددة. أمثلة:
- فاطمة (علامة التأنيث فيها التاء المربوطة).
- خرجتْ (علامة تأنيث الفعل التاء الساكنة).
- اخرجْن (علامة التأنيث في الفعل نون النسوة).
- الإعلال والإبدال والقلب والنقل: عمليات صرفية تغير من بنية الكلمة وفق قواعد محددة. مثال: كلمة “اصطنع” أصلها “اصتنع” (بدلالة المجرد “صنع” ووزنها “افتعل”). تم إبدال التاء إلى طاء لتحقيق الانسجام الصوتي.
-
تقسيم الاسم إلى صحيح ومقصور وممدود ومنقوص:
- الاسم الصحيح: ما كان آخره حرفًا صحيحًا (مثل: صديق).
- الاسم المقصور: ما انتهى بألف (مثل: عصا، كبرى).
- الاسم الممدود: ما انتهى بألف وهمزة زائدتين (مثل: صحراء، علماء).
- الاسم المنقوص: ما انتهى بياء (مثل: هادي).
-
التعجب: له صيغتان قياسيتان:
- ما أفعل! (مثل: ما أكرم العرب!).
- أفعل ب! (مثل: أكرمْ بالعرب من أمّة!).
- المصادر: أسماء تدل على أحداث مجردة من الزمان (مثل: دعاء، إدراك، استفادة).
- توكيد الفعل بالنون: توكيد الفعل المضارع بالنون الثقيلة أو الخفيفة (مثل: لتسعيَنَّ).
- إسناد الفعل إلى الضمائر: إسناد الأفعال إلى تاء الفاعل أو ياء المخاطبة أو نون النسوة أو غيرها من الضمائر (مثل: كتبتُ، كتبنا، كتبوا، كتبْن).
- المجرد والمزيد: الفعل المجرد ما كانت كل حروفه أصلية، والفعل المزيد ما كان في حروفه زيادة على الأصل (مثل: علم (مجرد)، تعلّم (مزيد بحرفين)، استعلم (مزيد بثلاثة حروف)).
- الصحيح والمعتل: الفعل الصحيح ما تخلو حروفه الأصلية من حروف العلة (مثل: رفع)، أما المعتل ما كان أحد حروفه علة (مثل: روى، دعا، وقى).
المصادر
- عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، صفحة 7. بتصرّف.
- [أحمد بن محمد الحملاوي]، شذا العرف في فن الصرف، صفحة 14. بتصرّف.