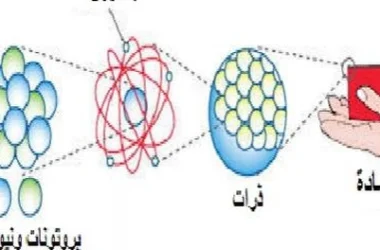فهم أنواع المجاز في علم البلاغة: المجاز، الاستعارة، والكناية
المجاز: استخدام اللفظ في غير معناه الحقيقي
في علم البلاغة، يميز العلماء بين اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي. اللفظ الحقيقي هو الذي يستخدم في معناه الاصلي، بينما اللفظ المجازي هو الذي يستخدم في غير معناه الحقيقي.
فمثلاً، كلمة “زهرة” تطلق على نبتة جميلة، وهذا هو معنى اللفظ الحقيقي. لكن عندما نقول “رأيت زهرة تبكي” فإنّ اللفظ ليس على حقيقته، لأنّ الزهرة لا تبكي فعلياً.
أنواع المجاز
ينقسم المجاز إلى عدة أنواع، من أهمها:
المجاز العقلي: إسناد اللفظ لغير حقيقه
المجاز العقلي هو نوع من المجاز حيث يُسنَد اللفظ إلى شيء لا يصحّ إسناده إليه في الحقيقة. لكن العقل يُدرك أنّ هذا الإسناد غير صحيح بسبب وجود قرينة تمنع ذلك.
مثلاً، يقول الشاعر:
> “هِيَ الأُمُورُ كَما شاهَدتُها دُوَلٌ
> مَن سَرّهُ زَمَن ساءَتهُ أَزمانُ”
في هذا البيت الشعري، لا يُمكن للزمن أن يُسعد الإنسان أو يُسوؤه، بل إنّ الله تعالى هو من يُسعد الإنسان أو يُسوؤه.
المجاز المرسل: توسيع استعمال اللغة
المجاز المرسل هو نوع من المجاز حيث تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي غير مشابهة. يمكن اعتبار هذه العلاقة كنوع من التوسع في استعمال اللغة.
وهناك عدة أنواع من المجاز المرسل، من أهمها:
* **السببية:** حيث يذكر السبب ويريد به المُسَبَّب، كقولنا: “رعت الماشية الغيث”.
* **المسببية:** حيث يذكر المُسبِّب ويريد به السبب، كما في قول الله تعالى: {وَیُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزقا}[سورة غافر، آية:13]
* **الكلية:** حيث يذكر الكل ويريد به الجزء، كما في قول الله تعالى: {یَجعَلُونَ أصابعهم فِی ءَاذَانِهِم}[سورة البقرة، آية:19]
* **الجزئية:** حيث يذكر الجزء ويريد به الكل، كقولنا: “شربت مياه النيل”.
الاستعارة: تشبيه مُختصر
الاستعارة هي نوع من المجاز يُشبه المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي، مع حذف أحد طرفي التشبيه (المشبه أو المشبه به).
فمثلاً، في قوله:
> “وَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤأً مِنْ نَرْجِسٍ وَسَقَتْ
> وَرْداً وَعَضَّتْ عَلَى العُنَّابِ بِالبَرَدِ”
يُشبه الشاعر البكاء بالإمطار، ويُشبه الدموع باللؤلؤ، ويُشبه العيون بالنرجس، ويُشبه الخدود بالورد، ويُشبه الشفاه بالعناب، ويُشبه الأسنان بالبرد.
الكناية: الإشارة للفظ ولزومهالكناية هي استخدام لفظ يُراد به لازم معناه، مع وجود قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. بمعنى آخر، يذكر لفظًا ويريد المعنى الذي يُفترض وجوده من وجود هذا اللفظ.
مثلاً:
* عندما نقول عن فتاة “مهوى القرط”، فنحن نُشير إلى أنّ عنقها طويلٌ، لأنّ هذا هو لازم وجود قرط طويل.
* نقول عن شخص “كثير الرماد”، فنحن نُشير إلى أنّ هذا الشخص جوادٌ كريم، لأنّ كثرة الرماد تدل على كثرة الطبخ.
* نقول عن شخص “كثير الإخوان”، فنحن نُشير إلى أنّ خلقه حسن، لأنّ كثرة الإخوان يدل على أنّ يعاملهم معاملةً حسنةً.
المراجع
- عبد الرحمن حبنكة، البلاغة العربية، صفحة 217- 218. بتصرّف.
- أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، صفحة 255. بتصرّف.
- أبو البقاء الرندي، “لكل شيء إذا ما تم نقصان”، الديوان، اطّلع عليه بتاريخ 21/1/2022.
- عبد الرحمن حبنكة، البلاغة العربية، صفحة 271. بتصرّف.
- أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، صفحة 252- 253. بتصرّف.
- المتنبي، “واحر قلباه ممن قلبه شبم”، الديوان، اطّلع عليه بتاريخ 20/1/2022.
- حسن إسماعيل عبد الرزاق، البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع، صفحة 58. بتصرّف.
* نقول عن شخص “كثير الرماد”، فنحن نُشير إلى أنّ هذا الشخص جوادٌ كريم، لأنّ كثرة الرماد تدل على كثرة الطبخ.
* نقول عن شخص “كثير الإخوان”، فنحن نُشير إلى أنّ خلقه حسن، لأنّ كثرة الإخوان يدل على أنّ يعاملهم معاملةً حسنةً.