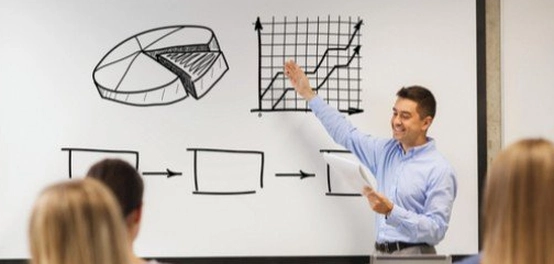جدول المحتويات
مقدمة إلى المدارس الفكرية الاقتصادية
تمثل المدارس الفكرية الاقتصادية تجميعًا للأفكار ووجهات النظر التي يتبناها مجموعة من الاقتصاديين الذين يشتركون في فهم مشترك لكيفية عمل الاقتصاد وتفسيره. هذه المدارس تقدم إطارات نظرية مختلفة لتحليل الظواهر الاقتصادية واقتراح السياسات المناسبة.
أسباب الاختلاف بين الاقتصاديين: لماذا ظهرت مدارس اقتصادية متنوعة؟
يعتمد التحليل الاقتصادي على كمية كبيرة من البيانات، والاقتصاديون قد يختلفون في كيفية تفسير هذه البيانات. تتضمن الأسباب الرئيسية لهذا الاختلاف ما يلي:
- التركيز المفرط على عوامل معينة: قد يولي بعض الاقتصاديين أهمية مبالغة فيها لعوامل محددة دون غيرها.
- سوء تفسير البيانات: قد يحدث خطأ في تحليل البيانات الاقتصادية واستخلاص النتائج.
- نماذج التنبؤ غير الكاملة: استخدام نماذج للتنبؤ بالمستقبل الاقتصادي قد يستبعد بعض العناصر الهامة.
- التحليل الشامل: على النقيض من ذلك، يقوم بعض الاقتصاديين بتحليل شامل يأخذ في الاعتبار جميع البيانات المتاحة.
أهم التيارات الفكرية الاقتصادية
فيما يلي نظرة عامة على بعض المدارس الفكرية الرئيسية في علم الاقتصاد:
الرؤية التجارية
هي فلسفة اقتصادية تبناها التجار ورجال الدولة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. يرى أتباع هذه المدرسة أن ثروة الأمم تأتي من تراكم الذهب والفضة. تسعى الدول التي لا تملك مناجم للذهب والفضة إلى الحصول عليهما من خلال تصدير السلع بكميات أكبر من استيرادها، وفرض التعريفات الجمركية للحد من الواردات وتعظيم الصادرات.
الفيزيوقراط
اقترح مؤسسو هذه المدرسة وجود نظام اقتصادي طبيعي لا يحتاج إلى تدخل الدولة لتحقيق الازدهار. وضع فرانسوا كيسناي، زعيم الفيزيوقراطيين، المبادئ الأساسية للاقتصاد الفيزيوقراطي في كتابه “الجدول الاقتصادي”، حيث تتبع تدفق الأموال والسلع في الاقتصاد.
قسم كيسناي المجتمع إلى ثلاث طبقات رئيسية:
- الطبقة المنتجة: العاملون في الزراعة وصيد الأسماك، ويمثلون نصف السكان.
- طبقة الملاك: مالكو الأراضي ومن يدعمهم، ويمثلون ربع السكان.
- طبقة الحرفيين: باقي السكان.
يختلف الفيزيوقراطيون مع أتباع المذهب التجاري في أنهم يعتبرون الطبقة الزراعية هي الطبقة المنتجة، بينما يرون أن الصناعة مهنة عقيمة لا تنتج ثروة جديدة.
المنهج الكلاسيكي
انتشرت هذه المدرسة في أواخر القرن الثامن عشر وحتى أواخر القرن التاسع عشر، وتأثرت بالمذهب التجاري والفيزيوقراطي. وضع آدم سميث غالبية مبادئ المدرسة الكلاسيكية في كتابه “بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم” عام 1776. رأى سميث أن التجارة الحرة والمنافسة الحرة هما أفضل طريقة لتحقيق النمو الاقتصادي، وعارض النظرية التجارية والتدخل الحكومي.
المنهج الحدي (الكلاسيكي الجديد)
تأسست هذه المدرسة في القرن التاسع عشر على يد ويليام جيفونز وليون والراس وكنوت ويكسل وكارل مينجر. يرى أتباعها أن القرارات الاقتصادية تتخذ عادة على الهامش، أي الوحدة التالية أو الإضافية. سيطر تحليل العرض والطلب ونظرية القيمة على تحليلات اتخاذ القرار من قبل المشاركين في السوق.
المنهج الماركسي
أنشأ مبادئها كارل ماركس الذي طرح نظريته النقدية المعروفة باسم نظرية العمل للقيمة. تشير هذه النظرية إلى أن قيمة العنصر تحدد من خلال مقدار الوقت الذي يستغرقه صنعه. يرى ماركس أن السلعة التي تباع هي عمل الموظف مقابل أجر، ولكن الرأسماليين لا يدفعون للعمال قيمة السلعة كاملة، إنما يدفعون لهم الأجر الضروري فقط للاحتياجات الأساسية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه” (صحيح البخاري).
المنهج المؤسسي
مدرسة اقتصادية ازدهرت في الولايات المتحدة خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. نظرت إلى تطور المؤسسات الاقتصادية كجزء من عملية أوسع للتنمية الثقافية. وضع ثورستين فيبلين الأساس للاقتصاد المؤسسي من خلال نقده للنظرية الاقتصادية الثابتة التقليدية. حاول فيبلين نشر فكرة أن الأفراد يتأثرون باستمرار بتغير المؤسسات والعادات بدلاً من مفهومهم كصانعي قرارات اقتصادية. ويرى أن الدافع المالي هو الدافع الأساسي للنظام الاقتصادي الأمريكي وليس التكنولوجيا.
المنهج الكينزي
في عام 1936، انفصل جون ماينارد كينز عن المدرسة الكلاسيكية كرد فعل على شدة الكساد العالمي، ونشر كتابه “النظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال”. تفترض وجهة النظر الكلاسيكية أن الأجور والأسعار يجب أن تنخفض في حالة الركود، بينما يرى كينز أن هبوط الأسعار والأجور يخفض دخل الناس ويمنع عودة الإنفاق. أكد كينز على أن التدخل الحكومي المباشر ضروري لزيادة إجمالي الإنفاق.
يركز المبدأ الكينزي على الطلب الكلي، حيث يرى أن الشركات لا تنتج إلا إذا كانت تتوقع بيعه. يحدد توافر عوامل الإنتاج الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للدولة، وبالتالي تعتمد كمية السلع والخدمات المباعة على مقدار الطلب.
قال تعالى: “وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ” (النجم: 39).