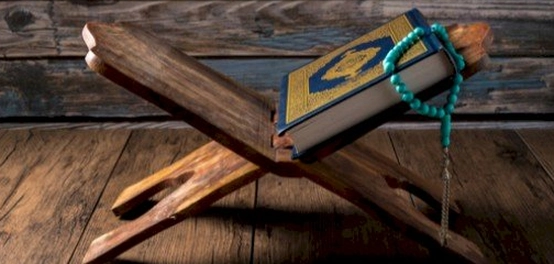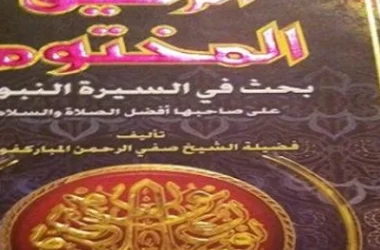محتويات
ما المقصود بالقلقلة؟
تعرف القلقلة لغوياً بأنها الاضطراب والتحريك[1]. أما اصطلاحاً في علم التجويد، فهي اضطراب اللسان وحركته عند نطق حروف القلقلة، خاصة إذا كانت ساكنة[2]، مما ينتج عنه نبرة قوية مميزة للحرف[3].
حروف القلقلة الخمسة
تتكون حروف القلقلة من خمسة أحرف[4]: القاف، الجيم، الطاء، الدال، والباء. يمكن تذكرها بسهولة من خلال أبياتٍ مثل “قطب جد”[6] أو “قد طبج”[5]. من المهم ملاحظة أن شدة القلقلة تختلف من حرف لآخر، حيث تكون أعلى ما يمكن عند الطاء، وأوسطها عند الجيم، وأقلها عند القاف، والباء، والدال[6]. ويرجع سبب اختيار هذه الحروف تحديداً لصفة الجهر والشدة المتلازمتين في كل حرف منها؛ فالجهر يمنع جريان النفس، والشدة تمنع جريان الصوت، مما يتطلب جهداً إضافياً في النطق، وهذا ما يستدعي القلقلة لتسهيل النطق[3].
تصنيفات القلقلة
اختلف العلماء في تصنيف مراتب القلقلة. بعضهم قسمها إلى أربعة مراتب[7]:
- قلقلة كبرى: حرف القلقلة متطرف في الكلمة ومشدد، مثل “الحقّ”، “الجَبّ”، “تَبّ”.
- قلقلة وسطى: حرف القلقلة متطرف وغير مشدد، مثل “حرج”، “محيط”، “العذاب”، “تحيد”، “واقف”.
- قلقلة صغرى: حرف القلقلة في وسط الكلمة وساكن، مثل “يقدر”، “ابتغاء”، “عدن”، “مطلع”، “يجتنبون”.
- قلقلة أصغر: حرف القلقلة متحرك، سواء كان متطرفاً أو في وسط الكلمة، مثل “الباب”، “طال”، “جانب”، “الدار”.
بينما قسمها آخرون إلى ثلاث مراتب[8] أو حتى مرتبتين فقط[9]، مع اختلاف طفيف في التفاصيل.
أساليب تطبيق القلقلة
تعددت آراء العلماء حول كيفية تطبيق القلقلة، ويمكن تلخيصها في ثلاث مذاهب رئيسية[10]:
- المذهب الأول: تتحدد حركة القلقلة بحركة الحرف السابق لها. فإذا كان الحرف السابق مفتوحاً، تكون القلقلة قريبة من الفتح، وإذا كان مضموماً تكون قريبة من الضم، وإذا كان مكسوراً تكون قريبة من الكسر.
- المذهب الثاني: تتحدد حركة القلقلة بحركة الحرف اللاحق لها بنفس طريقة المذهب الأول.
- المذهب الثالث: تكون القلقلة أقرب إلى الفتح دائماً، بغض النظر عن حركة الحرف السابق أو اللاحق.
كل هذه المذاهب تعكس اختلافاً في الفهم والتطبيق العملي للقاعدة، ولكن جميعها تسعى إلى تحقيق النطق الصحيح للحروف المقلقلة.
المصادر
- إبراهيم الجرمي (1422)،معجم علوم القرآن(الطبعة 1)، دمشق:دار القلم، صفحة 225. بتصرّف.
- محمود بسة (1425)،العميد في علم التجويد(الطبعة 1)، الإسكندرية:دار العقيدة، صفحة 65. بتصرّف.
- فريال العبد،الميزان في أحكام تجويد القرآن، القاهرة:دار الإيمان، صفحة 79. بتصرّف.
- إبراهيم الجرمي (2001)،معجم علوم القرآن، سوريا: دار القلم، صفحة 132. بتصرّف.
- ابن يعيش (1422)،شرح المفصل(الطبعة 1)، بيروت:دار الكتب العلمية، صفحة 524، جزء 5. بتصرّف.
- عطية نصر،غاية المريد في علم التجويد(الطبعة 7)، صفحة 145. بتصرّف.
- إبراهيم الجرمي (2001)،معجم علوم القرآن(الطبعة الأولى)، سوريا: دار القلم، صفحة 225. بتصرّف.
- فريال العبد،الميزان في أحكام التجويد، مصر: دار الإيمان، صفحة 80. بتصرّف.
- صفوت سالم (1424)،فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد(الطبعة 2)، جدة:دار نور المكتبات، صفحة 45. بتصرّف.
- محمود بسة (2004)،العميد في علم التجويد(الطبعة الأولى)، مصر: دار العقيدة، صفحة 66. بتصرّف.
- عطية نصر،غاية المريد في علم التجويد(الطبعة السابعة)، صفحة 145. بتصرّف.