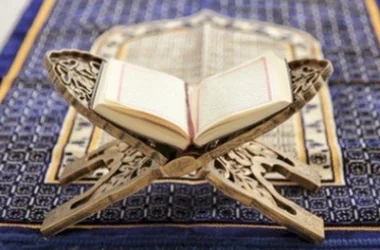فهرس المحتويات
| معنى التشابه العام |
| معنى التشابه الخاص |
| تصنيفات آيات المتشابه |
| المراجع |
معنى التشابه في اللغة العربية
يشير مصطلح “تشابه” في لغته الأصلية إلى وجود تقارب شديد بين شيئين أو أكثر، يصعب معه التمييز بينهما بسهولة. لكن الاستخدام الاصطلاحي للمصطلح اتسع ليشمل كل ما فيه غموض أو لبس في المعنى المقصود، أو صعوبة في إدراك حقيقته. سنوضح ذلك من خلال أمثلة:
مثال أول: قولنا “فلان يشبه فلاناً” يعني تقاربهما وتماثلهما، سواء في الصفات الظاهرة كالجسم والوجه، أو في الصفات الخفية كالكرم والشجاعة.
مثال ثانٍ: عبارة “اشتبه عليه الأمر” تعني التباس الأمر وغموضه، كما في قولنا “فلان مشبوه”، حيث يصبح التأكد من براءته أو إدانته أمراً صعباً.
يُمكن ربط المعنيين معاً، فالتشابه والتماثل قد يُسببان عجزنا عن التمييز، مما يؤدي إلى الالتباس والشك. وسنرى ذلك واضحاً في بعض آيات القرآن الكريم:
مثال من القرآن: قوله تعالى (وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا) [٢]، حيث تُشبه ثمار الجنة ثمار الدنيا في الشكل، لكنها أجمل وأفضل، مستخدمةً مألوفاً للإنسان ليُدرك الجمال المُضاف. هذا يبين جمال الله سبحانه وتعالى في خلقه، ويُظهر براعته في إبداعه.
مثال آخر من القرآن: قوله تعالى (إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا) [٤]، حيث اشتبه على بني إسرائيل اختيار البقرة المطلوبة من بين البقر الكثير المماثل.
مثال ثالث من القرآن: قوله تعالى (تتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ) [٦]، يشير إلى تماثل قلوب المشركين في ضلالهم وغيهم.
معنى التشابه في القرآن الكريم
اختلف العلماء في تعريف “المتشابه” في مقابل “المُحكم” في قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات) [٨]. ومن أهم الآراء:
- الآيات التي اختص الله بعلمها.
- الآيات التي تقبل أكثر من تفسير.
- الآيات العقدية التي نؤمن بها دون العمل بأحكامها.
- الآيات التي تحتاج إلى بيان وتوضيح.
- الآيات التي تحتاج إلى تدبر عميق لفهمها.
- الآيات التي تتضمن أخباراً وقصصاً.
- الآيات المنسوخة.
- الآيات التي دلالاتها غير واضحة تماماً.
أنواع آيات المتشابه
يمكن تصنيف آيات المتشابه حسب درجة غموضها إلى ثلاثة أقسام:
- الآيات التي يتعذر فهمها على الإطلاق: مثل الإحاطة بعلم الله وصفاته، أو معرفة وقت القيامة، وما شابه ذلك من الغيوب التي اختص الله بعلمها، كما في قوله تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ) [١١]، وقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ) [١٢].
- الآيات التي يمكن فهمها بسهولة: بمعرفة بسيطة باللغة العربية وأصول الدين، والتدبر في سياق الآيات، خصوصاً المتشابهات التي قد يُسبب غموضها إجمالها في موضع وبسطها في موضع آخر.
- الآيات التي يفهمها الخبراء فقط: فهي تحتاج إلى خبرة علمية عميقة وتدبر متخصص، ليصلوا إلى تفسيرها الصحيح. هذا يفسر الاختلاف في التفاسير بين العلماء.
المصادر
الآيات القرآنية مأخوذة من المصحف الشريف. أما التفسيرات والشروح، فمستمدة من مصادر متنوعة ومتعددة، وذلك لتقديم وجهة نظر شاملة ومتوازنة.