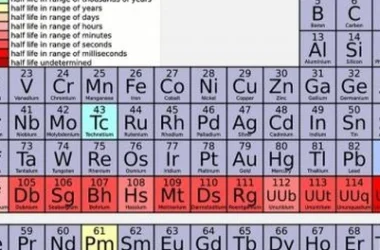جدول المحتويات
الاستعارة لغةً واصطلاحاً
لغةً، تُشير الاستعارة إلى نقل شيء من مكان إلى آخر، كما في قولنا “استعرتُ كتاباً من صديقي”، أي نقلته من ملكيته إلى ملكيتي. أما اصطلاحاً، فهي أسلوب بلاغيّ يُعنى باستعمال كلمة أو معنى في غير موضعه الأصلي، معتمداً على وجود شبه بين الكلمتين. يُعرّفها بعضُ البلاغيين بأنها تشبيه حُذف منه أحد أركانه، كقول الشاعر: “وإذا المنيّة أنشبت أظفارها”. هنا، شُبّه الموت (المنية) بوحش مفترس له أظافر، لكنّ المُشبَّه به (الوحش) حُذف، وبقي المُستعار (أظفارها) ليُعبّر عن شدّة الموت. ذلك بهدف إضفاء جمالٍ لغويٍّ وتوسيع دائرة المعنى.
عناصر الاستعارة الرئيسية
تتكون الاستعارة من عدة عناصر رئيسية: المُستعار منه (المُشبَّه به)، وهو المعنى الأصلي للكلمة؛ والمُستعار له (المُشبَّه)، وهو المعنى المجازيّ؛ والمُستعار، وهو اللفظ المُنتقل بين المُشبَّه والمُشبَّه به، ويُمثل وجه الشبه بينهما؛ والقرينة، وهي ما يُزيل اللبس ويوضح المعنى المراد. مثال ذلك قول الهذلي: “وإذا المَنِيّة أنشبَت أظفارَها”، فالمُستعار منه هو الحيوان المفترس، والمُستعار له هو الموت، والمُستعار هو “أظفارها”، والقرينة هي سياق الكلام الذي يُشير إلى الموت.
ومن أمثلة الاستعارة في القرآن الكريم: (وَاشتَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا)،[٤] حيث المُستعار منه (النار)، والمُستعار له (الشيب)، والمُستعار هو (اشتعل).
نشأة الاستعارة
استخدمت العرب الاستعارة قديماً بنقل كلمة إلى موقع كلمة أخرى مشابهة لها، إما جزئياً أو سببيّاً، كقولهم “أصابنا ربيعٌ باكرٌ” للدلالة على مطرٍ مبكرٍ في فصل الربيع. لكل استعارة معنى حقيقيّ، ورابطة بين المُستعار والمُستعار له لا تُفهم إلاّ بواسطة الاستعارة نفسها.
تصنيفات الاستعارة
تُقسَّم الاستعارة إلى أنواعٍ متعددة بناءً على معايير مختلفة:
الاستعارة من حيث ذكر أحد أطرافها:
الاستعارة التصريحية: يُذكر فيها المُشبَّه به صراحةً، كقول الله تعالى: (كِتابٌ أَنزَلناهُ إِلَيكَ لِتُخرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ)،[٩] حيث الظلمات والنور هما المُشبَّه به.
الاستعارة المكنية: يُحذف فيها المُشبَّه به، ويرمز إليه بلوازم أو مرافقات، كقول الشاعر: “لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المَشيب برأسه فبكى”.
الاستعارة من حيث اللفظ:
الاستعارة الأصلية: يكون المُستعار اسماً جامداً، كقول الشاعر: “عضَّنا الدهر بنابه”.
الاستعارة التبعية: يكون المُستعار اسماً مشتقاً أو فعلاً، كقول الله تعالى: (وَلَمّا سَكَتَ عَن موسَى الغَضَبُ)،[١١]
الاستعارة من حيث طرفيها:
الاستعارة المرشحة: تُذكر معها ما يلائم المُشبَّه به، كقول الشاعر: “إذا ما الدّهر جرّ على أناسٍ كلاكل أناخ بآخرين”.
الاستعارة المجردة: تُذكر معها ملائمات المُستعار له.
الاستعارة المطلقة: تخلو من ملائمات المُشبَّه والمُشبَّه به معاً.
الاستعارة من حيث تركيبها:
الاستعارة المفردة: يكون المُستعار لفظاً مفرداً.
الاستعارة المركبة: يكون المُستعار تركيباً، كقولنا: “لا تنثر الدرّ أمام الخنازير!”.
مميزات الاستعارة البلاغية
تُعَدّ الاستعارة من أساليب البلاغة الجميلة، فهي تُضفي معانيّ كثيرة بألفاظٍ قليلة، وتُشخّص المعاني الجامدة، وتُبرز صورًا جديدةً لها.
تحليل الاستعارة
يتمثل إجراء الاستعارة في تحليلها إلى عناصرها: المُشبَّه، المُشبَّه به، وجه الشبه، نوع الاستعارة، ونوع القرينة. مثال ذلك قول ابن المُعتز: “جُمِع الحقّ لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحا”.
الفرق بين الاستعارة والتشبيه
يُحافظ التشبيه على المعنى الحقيقيّ للجملة، بينما تُغيّر الاستعارة اللفظ والمعنى لتُعبّر عن معنى مجازيّ. كلُّ استعارةٍ تتضمّن معنى التشبيه، لكن ليس كلّ تشبيه استعارة.