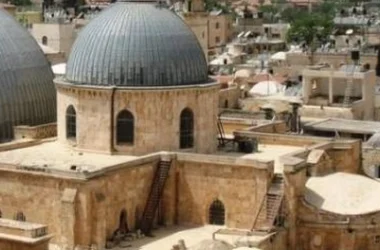التوقيت التاريخي لغزوة أحد
وقعت غزوة أحد في يوم السبت، الموافق السابع من شهر شوال في السنة الثالثة للهجرة. هذا يعني أنها حدثت بعد حوالي سنتين وسبعة أشهر من هجرة الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى المدينة المنورة.[١][٢] يشير القرآن الكريم إلى وقت وقوع الغزوة في قوله تعالى:
(وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)[٣]
وهذه الآية الكريمة تؤكد أن الغزوة وقعت في وقت الغدو، أي في النهار، وليس في الليل.[٤]
أُطلق على هذه المعركة اسم “غزوة أحد” نسبة إلى وقوعها بالقرب من جبل أحد، وهو جبل ذو لون أحمر يقع شمال المدينة المنورة، ويبعد عنها حوالي ميل واحد.[٥] سُمي جبل أحد بهذا الاسم لانفراده وتوحده عن سلسلة الجبال المحيطة به. وقد ورد ذكره في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، منها قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:
(أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهُ)[٦]
وقد فسر بعض العلماء هذا الحديث بأن المقصود هم أهل الجبل، بينما فهمه آخرون بمعناه الظاهر، قياسًا على قوله تعالى:
(وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّـهِ)[٧]
ويرى بعض العلماء أن سبب محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- لجبل أحد هو استبشاره برؤيته عند عودته من السفر، لقربه من منزله وأهله.[٨]
وقائع غزوة أحد
الدوافع وراء غزوة أحد
بعد الهزيمة التي تلقاها المشركون في غزوة بدر، توجه رجال من قريش فقدوا أقاربهم في المعركة إلى أبي سفيان، مطالبين إياه باستخدام أموال القافلة التي عادت بسلام لشن حرب على المسلمين. كان الهدف هو الثأر لمن قتل وجرح من القرشيين.[٩] استجاب أبو سفيان لهذا الطلب وبدأ في حشد قبائل العرب المتحالفة مع قريش للمشاركة في قتال المسلمين.[١٠]
استعدادات الجيوش للمعركة
قاد أبو سفيان جيشًا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل وتوجه به نحو المدينة المنورة، ونزلوا بالقرب من جبل أحد. عندما علم الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتحركهم، استشار الصحابة في كيفية التصدي لهذا الجيش. كان هناك رأيان: الأول، البقاء في المدينة والتحصن بها، وهو الرأي الذي كان يميل إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ والثاني، الخروج لملاقاة المشركين خارج المدينة، وهو الرأي الذي فضله أغلبية الصحابة -رضوان الله عليهم-.
استجاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- لرأي الأغلبية ودخل بيته وارتدى درعه وتقلد سيفه. ولكن بعد ذلك، شعر الصحابة الذين أشاروا بالخروج بالندم، وتمنوا لو أنهم لم يخالفوا رأي الرسول، وطلبوا منه العدول عن الخروج والبقاء في المدينة. إلا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال لهم:
(ما يَنْبَغِي لنبيٍّ لَبِسَ لَأْمَتَهُ أن يَضَعَها حتى يُحَكِّمَ اللهَ بينَه وبينَ عَدُوِّهِ).[١١][١٢]
خرج الرسول -صلى الله عليه وسلم- لملاقاة المشركين ومعه ألف مقاتل. ولكن بعد خروجهم من المدينة، انسحب عبد الله بن أبي بن سلول، زعيم المنافقين، ومعه ثلاثمئة من المنافقين، وعادوا إلى المدينة.[١٢]
أحداث ميدان المعركة
واصل الرسول -صلى الله عليه وسلم- مسيرته مع جيشه حتى وصل جبل أحد، وجعل ظهر المسلمين إلى الجبل. وعين عبد الله بن جبير -رضي الله عنه- قائداً لخمسين من الرماة، وأمرهم باتخاذ الجبل موقعاً لهم، وأكد عليهم البقاء في أماكنهم لحماية ظهر المسلمين وعدم مغادرة مواقعهم مهما حدث في المعركة، حتى يرسل إليهم. قال لهم الرسول -صلى الله عليه وسلم-:
(إنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فلا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ، هذا حتَّى أُرْسِلَ إلَيْكُمْ، وإنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وأَوْطَأْنَاهُمْ، فلا تَبْرَحُوا حتَّى أُرْسِلَ إلَيْكُمْ)[١٣]
التقى الجيشان في معركة شرسة، وبدا النصر في البداية حليفًا للمسلمين، وبدأ المشركون في التراجع والانسحاب.[١٢]
عندما رأى الرماة فرار المشركين، قرروا مغادرة الجبل طمعًا في الحصول على نصيبهم من الغنائم، ونزل جميع الرماة باستثناء قائدهم وعشرة رماة. استغل خالد بن الوليد هذه الفرصة والتف حول المسلمين وهاجمهم من الخلف، مما أدى إلى اضطراب صفوف المسلمين، خاصة بعد انتشار شائعة مقتل الرسول -صلى الله عليه وسلم-، مما دفع بعضهم للعودة إلى المدينة.[١٢]
لكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حافظ على ثباته، وثبت معه عدد من المسلمين الذين قدموا أروع الأمثلة في الدفاع عنه، منهم أبو دجانة -رضي الله عنه- الذي جعل ظهره درعًا يقي به الرسول من سهام المشركين، وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- الذي رمى قرابة ألف سهم في هذه الغزوة، ونسيبة أم عمارة الأنصارية -رضي الله عنها- التي دافعت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هي وزوجها وابنها.[١٣]
وقد أراد الله تعالى أن يخفف ألم ومصاب المسلمين في أحد، فأنزل قوله تعالى:
(وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)[١٤][١٢]
حصاد غزوة أحد
قُتل من المشركين في غزوة أحد أربعة وعشرون رجلاً، ولم يقع أسرى أو جرحى كثيرون. واستشهد سبعون من المسلمين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، كما ورد عن أُبيّ بن كعب -رضي الله عنه- قال:
(لمَّا كانَ يومُ أُحُدٍ قُتِلَ منَ الأنصارِ أربعةٌ وستُّونَ رجلًا ومنَ المُهاجرينَ ستَّةٌ)[١٥]
وكان من بين الشهداء عم الرسول -صلى الله عليه وسلم- حمزة بن عبد المطلب، وأبو حنظلة غسيل الملائكة.[١٦]
كان لالتفاف خالد بن الوليد حول المسلمين ومحاصرتهم من جميع الجهات دور كبير في زيادة الخسائر البشرية في صفوف المسلمين. إلا أن ذلك لا يعتبر هزيمة لهم لسببين: أولاً، نتيجة المعارك والحروب لا تقاس فقط بعدد الخسائر البشرية التي يتكبدها العدو، بل أيضًا بمدى تحقيق الهدف من القتال، وهو القضاء على القدرات المادية والمعنوية للعدو. وهذا لم يتحقق في صفوف المسلمين، والدليل على ذلك خروجهم لمطاردة قريش بعد يوم واحد من الغزوة. ثانيًا، نجاة قوة صغيرة من فناء محقق، بعد أن حاصرتها قوة كبيرة تفوقها عددًا بخمسة أضعاف، لا يعتبر هزيمة للقوة الصغيرة، بل هو فشل ذريع للقوة الكبيرة. ومما يدل على ذلك ما فعله خالد بن الوليد -رضي الله عنه- في غزوة مؤتة، حيث تمكن من إنقاذ جيش المسلمين من فناء محقق بخطة حربية استطاع من خلالها خداع العدو وتضليلهم وتنظيم انسحاب جيش المسلمين والعودة به إلى المدينة، فاستقبلهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- وحياهم أحسن تحية، واعتبر رجوعهم ونجاتهم انتصارًا.[١٧]
المصادر
- السيد الجميلي (1416ه), غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم, بيروت: دار ومكتبة الهلال, صفحة 59. بتصرّف.
- أحمد غلوش (1424هـ – 2004م ), السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني (الطبعة الأولى), بيروت: مؤسسة الرسالة, صفحة 320. بتصرّف.
- سورة آل عمران, آية: 121.
- موسى العازمي (1432هـ – 2011م ), اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (الطبعة الأولى), الكويت: المكتبة العامرية , صفحة 564, جزء 2. بتصرّف.
- ياقوت الحموي (1995م), معجم البلدان (الطبعة الثانية), بيروت: دار صادر, صفحة 109, جزء 1. بتصرّف.
- رواه البخاري, في صحيح البخاري, عن أبي حميد الساعدي, الصفحة أو الرقم: 1481 , صحيح.
- سورة البقرة, آية: 74.
- ابن كثير (1424هـ – 2003م ), البداية والنهاية (الطبعة الأولى), القاهرة: دار هجر, صفحة 337, جزء 5. بتصرّف.
- عبد الرحمن السهيلي (1412ه), الروض الأنف في شرح السيرة النبوية (الطبعة الأولى), بيروت: دار إحياء التراث العربي, صفحة 419, جزء 5. بتصرّف.
- منير الغضبان (1413هـ – 1992م ), فقه السيرة النبوية (الطبعة الثانية), مكة المكرمة: جامعة أم القرى, صفحة 447. بتصرّف.
- رواه الألباني, في فقه السيرة, عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري, الصفحة أو الرقم: 250, صحيح.
- مصطفى السباعي (1405هـ – 1985م), السيرة النبوية دروس وعبر (الطبعة الثالثة), دمشق: المكتب الاسلامي, صفحة 82-86. بتصرّف.
- رواه البخاري, في صحيح البخاري, عن البراء بن عازب, الصفحة أو الرقم: 3039 , صحيح.
- سورة آل عمران, آية: 139-140.
- رواه الألباني, في السلسلة الصحيحة, عن أُبيّ بن كعب, الصفحة أو الرقم: 5/491, حسن.
- أحمد غلوش (1424هـ – 2004م), السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني (الطبعة الأولى), بيروت: مؤسسة الرسالة, صفحة 361. بتصرّف.
- محمد النجار, القول المبين في سيرة سيد المرسلين, بيروت: دار الندوة الجديدة , صفحة 252-253. بتصرّف.