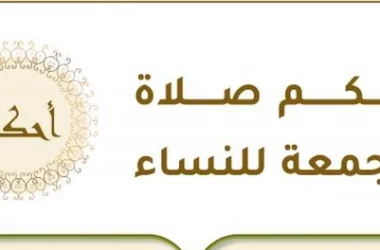فهرس المحتويات
- الهجرة لغة واصطلاحاً
- دوافع الهجرة النبوية ونتائجها
- أسباب الهجرة المباركة
- ثمار الهجرة النبوية
- مواقف تُبرز ثبات النبي خلال رحلته
- المراجع
معنى الهجرة: بين اللغة والاصطلاح
يُشتقّ مصطلح “الهجرة” من الفعل “هجر”، وهو ضدّ “الوصل”. فالهجرة لغوياً هي ترك مكان ما والانتقال إلى آخر، كما جاء في معجم لسان العرب لابن منظور. ويُعرّفها معجم اللغة العربية المعاصرة بأنها اسم مرة من الهجر. وبالتالي، يُمكن فهم الهجرة اللغويًا على أنها ترك أو مغادرة. أما اصطلاحاً، فتُعرّف الهجرة في الإسلام بأنها انتقال من دار كفر أو خوف إلى دار إيمان وأمان، حفاظاً على الدين. وقد عرّفها الجرجاني بأنها “ترك الوطن الذي بين الكفار والانتقال إلى دار الإسلام”. أما الهجرة النبوية تحديداً، فهي انتقال رسول الله ﷺ ومن معه من المسلمين من مكة إلى المدينة المنورة قبل فتح مكة.
الهجرة النبوية: دوافعها وآثارها البالغة
لقد كانت للهجرة النبوية أسبابها العميقة ونتائجها الباهرة التي غيرت مجرى التاريخ.
أسباب الهجرة إلى المدينة المنورة
كانت للهجرة النبوية دوافع متعددة، منها:
- رفض قريش لدعوة الإسلام ومحاربتهم للرسول ﷺ و المسلمين.
- استعداد أهل المدينة لقبول الإسلام والدفاع عنه.
- إيذاء المشركين للرسول ﷺ وتعذيبه للمسلمين، حتى استشهد منهم من استشهد.
- ضرورة إقامة دولة إسلامية قائمة على التوحيد.
- اتباع سنة الأنبياء في نشر الدعوة وإعلاء كلمة الله.
ثمار الهجرة النبوية على المجتمع الإسلامي
أثمرت الهجرة النبوية نتائج عظيمة، منها:
- تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
- بناء الدولة الإسلامية وإرساء دعائم العلاقة بين المسلمين وغيرهم.
- تنمية الاقتصاد الإسلامي بتشجيع التجارة.
- تكوين قوة عسكرية قوية للدفاع عن الإسلام.
- إنشاء بيوت تربوية في المساجد، حيث كان المسجد بمثابة المدرسة والبيت للرسول ﷺ وأصحابه.
- انتشار الإسلام ودخول أعداد كبيرة في الإسلام.
صمود النبي ﷺ خلال رحلة الهجرة
كانت رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة محفوفة بالمخاطر، فقد كان النبي ﷺ وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما يهربان من قريش التي كانت تبحث عنهما. لكن النبي ﷺ كان ثابتاً وصبوراً في كل مراحل الهجرة. ومن المواقف التي تُبرز ذلك:
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (كُنْتُ مع النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الغارِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فإذا أنا بأَقْدامِ القَوْمِ، فَقُلتُ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، لو أنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَآنا، قالَ: اسْكُتْ يا أبا بَكْرٍ، اثْنانِ اللهُ ثالِثُهُما)،[٨] فكان النبي ﷺ واثقاً من حماية الله له.
كما أن النبي ﷺ لم يلتفت كثيراً عندما لحق به سراقة بن مالك، ليقينه بعدم قدرة سراقة وقريش على إيقافه.
المراجع
- ابن منظور، كتاب لسان العرب.
- أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة.
- الجرجاني، الشريف، كتاب التعريفات.
- رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي بكر الصديق، حديث صحيح.