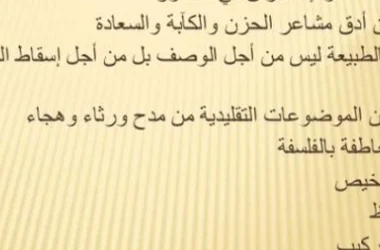مقدمة عن بدر شاكر السياب
بدر شاكر السياب، قامة شعرية عراقية بارزة، يعتبر من أبرز رواد التجديد في الشعر العربي الحديث. كان له دور ريادي في تأسيس مدرسة الشعر الحر، جنباً إلى جنب مع شعراء آخرين مثل صلاح عبد الصبور وأمل دنقل ولميعة عباس عمارة. ما يميز شعر السياب هو تدفقه العاطفي وتجاوزه للأشكال التقليدية للقصيدة، فضلاً عن طغيان نبرة الحزن التي تعكس ظروف حياته الصعبة على الأصعدة الاجتماعية والنفسية والصحية، وتحديداً مرضه الذي أودى بحياته في الرابع والعشرين من كانون الأول عام 1964م.
لمحة عن حياة السياب
ولد بدر شاكر بن عبد الجبار بن مرزوق في عام 1926، في تاريخ غير محدد حتى بالنسبة للشاعر نفسه، حيث نسي والده تسجيل تاريخ ميلاده بدقة. كانت ولادته في قرية صغيرة متواضعة تقع جنوب العراق وتدعى “جيكور”، تتميز بطبيعتها الخلابة. كان معظم سكان هذه القرية يعتمدون على زراعة النخيل كمصدر رزقهم. كان والده، شاكر عبد الجبار، يعمل مثل غيره من سكان القرية في زراعة النخيل، ويعيش في ظروف مادية صعبة في بيت العائلة الكبير. أنجبت والدته، كريمة، وهي ابنة عم والده، ولدين آخرين غير بدر، وهما عبد الله ومصطفى، وابنة توفيت هي ووالدتها بعد ولادتها في عام 1930، مما جعل بدر يتيماً في سن السادسة. نشأ بدر متنقلاً بين بيت جده لأبيه وجدته لأمه.
تطورات المراحل الشعرية
بدأ السياب مسيرته الشعرية في سن مبكرة، حيث بدأ بنظم الشعر باللهجة العراقية العامية، ثم انتقل إلى الشعر الفصيح متبعاً نهج شعراء المدرسة الرومانسية. إلا أن شعره في تلك المرحلة لم يتميز بابتكار أو تفرد، خاصة في بناء القصيدة. خلال هذه الفترة، أنتج ديواني “أزهار ذابلة” و”أساطير”. مع نهاية الحرب العالمية الثانية وتأثر البلاد بثقافات مختلفة، دخل السياب مرحلة جديدة تميزت بغزارة الإنتاج، حيث ألف عدة دواوين شعرية مهمة مثل “أنشودة المطر” و”المعبد الغريق” و”منزل الأقنان” و”شناشيل ابنة الجلبي”. في هذه المرحلة، بدأ شعره يبتعد عن مسار الشعر التقليدي القديم، واتجه نحو بناء أنماط جديدة للقصيدة، ليصبح من أبرز الشعراء المجددين في الشعر العربي الحديث. في نهاية الأربعينيات، كتب أول قصيدة له بأسلوب جديد من حيث الوزن والقافية، افتتح بها مشروعه الحداثي وهي قصيدة “هل كان حباً”.
ملامح شعر السياب
البناء اللغوي والكلمات
استخدام تعابير جديدة: كان السياب يرى أن الشاعر الحديث يجب أن يبتكر تعابير جديدة في نصوصه الشعرية، حيث قال: “إن الشاعر الحديث مطالب بخلق تعابير جديدة، إن عليه أن ينحت لا أن يرصف الأجر القديم”. وقد تميز شعره باستخدام التعابير الجديدة، كما في قصيدته “ابن الشهيد”:
يا ليتني ما زلتُ في لعبي
في ريف جيكور الذي لا يميلُ
عنه الربيع الأبيض الأخضر
السّهل يندى و الرّبى تُزهرُ
ويُطفئ الأحلام في مُقلتيك
كأنها مِنفضة للرمادْ
همس كشوكٍ مسّ من جبهتي
يُنذر بالسارين فوق الجيادْ
يُلاحظ في المثال السابق ترابط التراكيب اللغوية وانصياعها للفكرة ودلالاتها، وهو ما يميز معظم النصوص الشعرية عند السياب الذي كان مهتماً باستكشاف اللغة والأسلوب القديمين منذ بداياته.
استخدام الألفاظ المضعفة: كثرت الألفاظ المضعفة في نصوص السياب الشعرية، والتي أضفت على النص سمات موسيقية ودلالية، مثل (هسهسة، وغمغمة) اللتين جاءتا في قصيدته “أطفال وأسلحة”:
عصافير؟ أم صبيةٌ تمرح
عليها سناً من غدٍ يلمح؟
وأقدامها العارية
مُحارٌ يُصلصل في ساقية
لأذيالهم رفة الشمألٍ
سرت عبر حقلٍ من السَنبلو
هسهسة الخبز في يوم عيدْ
وغمغمة الأم باسم الوليدْ
تناغيه في يومه الأول
استخدام الألفاظ العامية والشعبية: أكثر السياب في شعره من استخدام الألفاظ العامية العراقية الدارجة بعد أن طوعها مبرزاً جمالياتها في إيصال فكرته ومشاعره للمتلقي، ومن هذه الألفاظ: (كوخ، شناشيل، مجداف، تنور، دندنة…إلخ).
استخدام الألفاظ المكانية: انتشرت ألفاظ المكان في قصائد السياب مثل: (البيت، النافذة، الجدار، النهر، المدينة، جيكور، بويب..إلخ) ومثال على تلك الألفاظ ما جاء في قصيدته “أفياء جيكور”:
جيكور، جيكور ياحقلاً من النور
ثم قال:
جيكور مسّي جبيني فهو ملتهب
مسّيه بالسَّعِفِ والسنبل الترف
الصورة الفنية
يمكن تعريف الصورة الفنية بأنها قدرة المبدع على إنتاج صورة بيانية أو بلاغية تعبر عن الهيئة الحسية والشعورية بالربط بين شبيهين أو شكلين، ويرى السياب الصورة الفنية على أنها “نسخة جمالية تستحضر فيها لغة الإبداع الهيئتين الحسية والشعورية للأجسام أو المعاني، بصياغة جديدة تمليها موهبة المبدع وتجربته وفق تعادليّة فنية بين طرفين هما المجاز والحقيقة” كما قال، وقد امتلأ شعره بالصور الفنية المختلفة، إذ اتخذ منها وسيلة للتعبير عن أفكاره وعواطفه، والتي من أهم ميزاتها:
استخدامه للمجاز بكثرة كما في النص الآتي حيث استخدم الاستعارة، فاستعار خاصية الهمس من الإنسان إلى سعف النخيل:
في ليلة قمراء سكرى بالأغاني، في الجنوب
نقرالدرابك من بعيد
يتهامس السعف الثقيل به، ويصمت من جديد
الاستعانة بالقصص الأسطورية: سبق السياب شعراء جيله في اكتشاف قيمة الأسطورة في إثراء النص الشعري من الناحية الفنية والفكرية، فشغلت الأسطورة حيزاً كبيراً في قصائده إذ جعلها رموزاً في أشعاره، وهي رموز تعود لحضارات مختلفة كالحضارة البابلية والأشورية والرومانية واليونانية والفرعونية والعربية الشعبية، ومن هذه الرموز ما هو حقيقي وما هو خرافي، مثل: (المسيح، السندباد، أيوب، أوديب، عشتار، تموز..إلخ)، ويجدر القول أنّ كثرة استخدام السياب للأسطورة أضفى على قصائده جمالاً وإبداعاً رغم الغموض الذي أحاط بها، ومن الأمثلة على استخدام السياب للأسطورة قوله في قصيدة “غريب على الخليج”:
غنيت تربتك الحبيبة
وحملتها فأنا المسيح يجرّ في المنفى صليبه
المستوى الدلالي
ترك السياب وراءه إرثاً شعرياً غزيراً في المعنى والمبنى رغم قصر عمره ومصاعب حياته، خصوصاً يتمه وحرمانه من حنان أمه، إضافة إلى مرضه وفقره، وهذا دليل على عبقريته وسعة ثقافته. كان لتلك الظروف أثر كبير في شعره، حيث جسد حياته في ذلك الشعر بآلامها الجسدية والنفسية، وأنتج قصائد كوّنتها تجربته الذاتية تعددت موضوعاتها الشعرية بشكل كبير جداً، وامتلأت بذكر ألفاظ الشقاء: (كالموت، والمنية، والردى، والوصية، والحزن، والغربة) وما إلى ذلك من ألفاظ كئيبة.
الأفكار الرئيسية في شعر السياب
الزمان والمكان
لعب مفهوم الزمان والمكان دوراً كبيراً في شعر السياب، وقد تجلى إبداعه في وعيه بزمانه ومكانه من خلال تجربته الإنسانية بشكل عام والذاتية بشكل خاص، وقد ارتبط المكان والزمان عند الشاعر ببعضهما وشكلا جزءاً مركزياً من البناء النفسي والعاطفي لديه، فإحساسه بالمكان ولد عنده إحساسه بالزمان، إذ تمثلت في شعره الأزمنة على شكل شخوص وأشياء مكانية، وكان تركيزه منصباً على الزمان والمكان الأسطوري الخيالي هروباً من الواقع. أما المكان الذي ارتبط به شاعرنا وكان له حضوراً قوياً في شعره، فهو قريته التي نشأ بها، والتي هي بالنسبة له أكبر بكثير من كونها رقعة جغرافية، حيث استطاع عن طريقها إثارة الكثير من المعاني، وتشكيل نصوص شعرية كثيفة ذات دلالة زمانية ومكانية اتسمت بصدق العاطفة وعمق انتماء الشاعر لقريته جيكور.
يحن السياب إلى جيكور كمكان ارتبط في ذهنه بزمن سعيد حيث طفولته وأيام صباه، فيستدعي ذكرياته فيها لأن آلام الحاضر وهمومه أثقلت كاهله وبعثت في أعماقه الشوق والحنين إلى ذلك الزمن، فيحاول الشاعر الهروب من حاضره ملتمساً الراحة حتى وإن كانت في الخيال، وحين يستدعي السياب جيكور المكان يستدعي الزمن أيضاً، إذ لا يمكن إلا أن يستدعيهما معاً، لأن ذكرياته ليست مرتبطة بالمكان وحده بل بالزمان أيضاً، فجيكور المكان دون الزمان مقفرة. يصف السياب في قصيدة له جيكور عند عودته ورؤيته لها وقد غيرتها عوامل الزمن، وحولت بيت جده إلى مكان خاو لا حياة فيه، وهو إذ يصف ذلك إنما يصف حزنه لرؤية المكان الذي احتضن ماضيه قد غير ملامحه الزمان، فيقول:
وحين تقفر البيوت من بناتها
وساكنيها، من أغانيها ومن شكاتها
نحسّ كيف يسحق الزمان إذ يدور
الرمزية
يُعد السياب أكثر الشعراء العراقيين توظيفاً للرمز والأسطورة في نصوصه الشعرية، بسبب معاناته الجسدية والنفسية وأحوال العراق السياسية، متبعاً أسلوب أبي تمام وإديث ستويل، وهذا ما أخبر به السياب نفسه حيث قال: “أغلب قصائدي هي مزيج من طريقة أبي تمام وطريقة إديث ستويل: إدخال عنصر الثقافة والاستعانة بالأساطير والتأريخ والتضمين في كتابة الشعر”. وقد طور السياب المذهب الرمزي بأسلوبه المتفرد، فابتدع رموزاً شخصية وأقنعة شعرية تخفى خلف شخوصها ليستطيع أن يمرر عبرها أفكاره وآماله، واتكأ عليها في التعبير عن معاناته الشخصية ومعاناة وطنه، فاستطاع بواسطتها التقريب بين الرمز والواقع، وقد وسمت هذه الرموز شعره بالأصالة وأضفت عليه جمالاً وسحراً نادرين.
كثرت الرموز في شعر السياب وتنوعت وتشعبت، ومن أهم الصور الرمزية ظهوراً في شعره (المرأة) التي شغلت جزءاً كبيراً من أشعاره وشكلت الكثير من الإيحاءات والدلالات المختلفة، ومن تلك الصور الرمزية مثلاً: المطر في قصيدة “المطر” الذي يرمز إلى الأم والحبيبة وإلى أرض العراق، (وجميلة) التي ترمز إلى النضال والكفاح والتضحية في قصيدة “جميلة بوحيرد”، أما (إقبال) في قصيدة “الوصية” فهي رمز لجيكور.
استطاع السياب من خلال استخدامه للرمز أن يعبر عن خلجات نفسه، فمزج بين الرمز ومعاناته الشخصية كي يستطيع مواجهة آلامه، وجسد هموم الإنسان وأحلامه مستعيناً بكل ما في الرمز من دلالات جمالية وطاقات إيحائية، وقد لجأ إلى التخفي وراء الرمز ليستطيع محاربة قوى الفساد التي ليس من الممكن محاربتها بشكل مباشر، فوجد في الرمز ملاذاً آمناً استطاع عن طريقه تجاوز عالم الوعي إلى اللاوعي هروباً من الواقع المضطرب.
الإغتراب
يتضح من خلال دراسة النص الشعري للسياب والولوج في أعماقه تحليلاً أنه عانى من حالات عدة من الاغتراب، ويُعد اغتراب الإنسان المكاني والروحي بكل ما يحمل من شمولية في المعنى من أهم ما يميز المضمون الإنساني لإنتاج الشاعر، وقد امتلأت نصوص السياب الشعرية بمفردات عبر بها عن شعوره بالاغتراب أظهرت بشكل جلي معاناته وآلامه، ومن هذه الألفاظ: (الوحيد، الطريد، الشريد، الغريب، الحزين، القبر..إلخ)، وما إلى ذلك من مفردات جسدت معاني الغربة عند السياب وشكلت جوهر شعره وأظهرت براعته في التعبير عن أوجاعها، وقد ارتبط شعوره بالاغتراب بفقدانه لأمه وأبيه وجدته، إذ كان هذا أول وأكبر اغتراب له في حياته، لكنه ظل دفيناً في نفسه واستر في التعاظم، لا سيما في ظل تردي أحوال الواقع الذي كان يعيش فيه بما في ذلك صراع القيم بين الحاضر والماضي.
وصف السياب شعوره بالاغتراب بإبداع في نصوصه الشعرية وصوره كما لم يصوره شاعر في عصره، ومن ذلك النص الآتي حيث وصف فيه حنينه إلى أمه في ليالي الخريف الطويلة:
في ليالي الخريفِ الطِّوال
آهِ لو تَعلمِين
كيف يَطغى عليَّ الأسى والمِلال؟!
في ضلوعي ظلامُ القُبورِ السجين
في ضلوعي يصيح الرَّدَى
بالتراب الذي كان أمي: «غدًا
سوف يأتي، فلا تُقلقي بالنحيب
عالمَ الموتِ، حيث السكونُ الرهيب
الشعراء الذين أثروا في السياب
تأثر السياب أثناء تطور مراحل شعره ببعض شعراء العرب القدامى والمحدثين وبعض شعراء الغرب، لاسيما في الخمسينيات إذ تأثر آنذاك بالشاعرين البريطانيين وليم شكسبير وجون كيتس، وقد نقل عن السياب قوله: “وأكاد أعتبر نفسي متأثراً بعض التأثر بكيتس من ناحية الاهتمام بالصور، بحيث يعطيك كل بيت صورة، وبشكسبير من ناحية الاهتمام بالصور التراجيدية العنيفة، وأنا معجب بتوماس إليوت، متأثر بأسلوبه لا أكثر، ولا تنس دانتي فأنا أكاد أفضّله على كل شاعر”، ويذكر أن السياب ذكر في عام 1956م أن البحتري هو أول شاعر تأثر به، ثم تأثر بعد ذلك بالشاعر المصري علي محمود طه فترة من الزمن، وأنه قد أفاد من مطالعته لترجماته للشعراء البريطانيين والفرنسيين حيث تعرف على ألوان جديدة من الشعر.
ذكر السياب أيضاً أنه قد تأثر بأبي تمام وبالشاعرة البريطانية سيتويل فقال: “حين أراجع إنتاجي الشعري ولا سيما في مرحلته الأخيرة أجد أثر هذين الشاعرين واضحين، فالطريقة التي أكتب بها أغلب قصائدي الآن هي مزيج من طريقة أبي تمام وطريقة إديث سيتويل”، وقد كان السياب معجباً بالشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري الذي لقب بمتنبي العصر، وكثيراً ما أشاد به واعتبره أعظم شاعر وخاتم شعراء النهج التقليدي للشعر العربي.
أعمال بدر شاكر السياب
للسياب إرث كبير ومتنوع، يذكر منه:
- الدواوين الشعرية: صدر للسياب مجموعة من الدواوين الشعرية منها ما نشر في حياته وهي: (أزهار ذابلة، وأساطير، وحفار القبور، والمومس العمياء، والأسلحة والأطفال، وأنشودة المطر، والمعبد الغريق، ومنزل أفنان، وأزهار وأساطير)، ومنها ما جمع بعد مماته وهي: (شناشيل ابنة الجلبي، وإقبال، وقيثارة الريح، وأعاصير، والهدايا، والبواكير، وفجر السلام).
- الشعر المترجم: كان منه (الحب والحرب، وقصائد عن العصر الذري عن إيديث ستيول، وقصائد مختارة من الشعر العالمي الحديث وقصائد من ناظم حكمت).
- الأعمال النثرية: تعد محاضرة “الالتزام واللاالتزام في الأدب العربي الحديث” التي ألقاها السياب في مؤتمر الأدب العربي المعاصر الذي أقيم في روما مثالاً على هذا النوع من المؤلفات.
- الأعمال النثرية المترجمة: إن من الأمثلة على الأعمال النثرية المترجمة (ثلاثة قرون من الأدب) الذي صدر في جزئين، ومسرحية الشاعر والمخترع والكولونيل لبيتر أوستينوف، وتقع في فصل واحد.
المراجع
- بدر شاكر السياب
- المهارات الأساسية في اللغة العربية، صفحة 143.
- بدر شاكر السياب، حيدر بيضون، (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 13-16.
- بدر شاكر السياب، ثورة الشعر ومرارة الموت، هاني الخير، دمشق – سوريا: دار رسلان للطباعة والنشر، صفحة 16.
- لغة الشعر عند السياب، موسى القيسي، العدد السابع والثامن، المجلد الرابع، صفحة 439-462.
- المكان وتشكيلاته في شعر السياب، سوسن حسن، مجلة كلية الآداب جامعة بور سعيد، العدد السابع، صفحة 103-122.
- بدر شاكر السياب، أسماء حيدر، بغداد- العراق: الجامعة المستنصرية، صفحة 7.
- المؤثرات الاجتماعية في نشوء الشعر الحر، شعر بدر شاكر السياب أنموذج، خالد الشرفات، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 4، المجلد 45، صفحة 404.