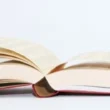اللغة في أشعار الجاهلية
عندما نتأمل في الفترة الجاهلية، التي تبدأ قبل 150 عامًا من البعثة النبوية، نجد لغة عربية متكاملة تمامًا في جميع جوانبها: الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية. يبدو انتشار هذه اللغة وكأنه إعجاز، حيث تبتعد بشكل كبير عن اللهجات القديمة، لدرجة يصعب معها إيجاد صلة قوية، باستثناء بعض الخصائص اللغوية المحدودة.
على سبيل المثال، في اللهجة النبطية، التي تعتبر من أقرب اللهجات وأكثرها ارتباطًا باللغة الفصيحة، نجد عبارة مثل: “كن لهو خلفتن وقسد”، والتي تعني في الفصيحة: “كن له خليفةً وقائد”. وقد سيطرت لغة العرب الشماليين، وهي لغة الأدب الجاهلي، على لغة العرب الجنوبيين.
على الرغم من ظهور لهجات متقاربة جدًا في الخصائص خلال هذه الفترة، إلا أن العرب اتفقوا على استخدام لهجة قريش كلغة للأدب العام، وهي اللغة التي نظم بها الشعراء من مختلف الخلفيات و اللهجات قصائدهم.
إن اتفاق جميع هذه القبائل على استخدام هذه اللغة يعتبر في حد ذاته معجزة. فكيف يتخلى العربي، الذي يفتخر بذاته وقبيلته ولهجته، عن لهجته وينظم شعره بلغة أخرى؟ هذه اللهجة القرشية هي التي أصبحت اللغة العربية الفصحى، والتي نزل بها القرآن الكريم فيما بعد.
اللهجات الجاهلية وأوصافها
كما ذكرنا، توافق العرب على تبني لغة قريش كلغة أدبية موحدة، مما سهل انتشار الأعمال الشعرية والأدبية. ومع ذلك، إلى جانب لغة قريش، استمرت لهجات أخرى بالوجود والتداول بين قبائل عربية مختلفة. هذه اللهجات لم تندثر تمامًا، بل استخدمت في التواصل اليومي وفي بعض الأحيان في الشعر. من بين هذه اللهجات:
العنعنة عند تميم
وهي استبدال الهمزة بحرف العين، فيقولون “عنت وعنك” بدلاً من “أنت وأنك”.
القلقلة لدى بهراء
وهي كسر ياء المضارع، فيقولون “يِلعب ويِذهب” بدلاً من “يَلعب ويَذهب”.
الكسكسة عند تميم
وهي إضافة سين بعد كاف المخاطبة، فيقولون “رأيتكِس” بدلاً من “رأيتكِ”.
الكشكشة لدى أسد
وتنسب أحياناً إلى ربيعة، وهي استبدال كاف المخاطبة بحرف الشين، فيقولون “رأيتش” بدلاً من “رأيتكِ”.
الفحفحة عند هذيل
وهي استبدال الحاء بحرف العين، فيقولون “عتى” بدلاً من “حتى”.
الوكم عند ربيعة
وهي كسر كاف الخطاب بعد الياء أو الكسرة، فيقولون “عليكِم” بدلاً من “عليكُم” و “بِكِم” بدلاً من “بِكُم”.
الوهم لدى بني كلب
وهي كسر هاء الغيبة إذا لم تسبق بكسرة أو ياء ساكنة، فيقولون “بينهِم” بدلاً من “بينهُم”.
الجمجمة عند قضاعة
وهي استبدال الياء الأخيرة بحرف الجيم، فيقولون “الساعج” بدلاً من “الساعي”.
التميم لدى أهل اليمن
وهي قلب السين في آخر الكلمة تاءً، فيقولون “النات” بدلاً من “الناس”.
الاستنطاء عند سعد والأزد وقيس
وهي قلب العين الساكنة نوناً، فيقولون “أنطى” بدلاً من “أعطى”.
الشلشلة في اليمن
وهي استبدال الكاف بحرف الشين، فيقولون “لبيش” بدلاً من “لبيك”.
اللخلخانية في الشحر
وهي حذف الألف فيقولون “مشاء الله” مكان “ما شاء الله”.
الطمطمانية في حمير
وهي تحويل أل التعريف إلى (أم)، وقد كلمهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدموا عليه فقال لهم: “ليس من امبر امصيام في امسفر،” يعني ليس من البر الصيام في السفر.
الغمغمة عند قضاعة
وهي إخفاء الحروف في الكلام حتى تكاد لا تظهر.
جذور اللغة العربية
تعتبر اللغة العربية إحدى اللغات السامية، ويمكن القول بأنها تطورت عن اللغة السامية الأم، جنبًا إلى جنب مع اللغات الأخرى المنحدرة منها، مثل الآرامية والعبرية. يمكن اعتبار العربية لغة حافظت على أصولها السامية بشكل كبير، بينما شهدت اللغات الأخرى تغيرات ملحوظة.
بشكل عام، يمكننا التأكيد على أن العربية تنتمي إلى عائلة اللغات السامية، وأنها حافظت على ظاهرة الإعراب التي كانت موجودة في اللغة السامية الأم. أما ما يتجاوز ذلك، فهو مجرد نظريات وآراء قابلة للنقاش، ولكن لا يمكن الجزم بها.
بالنسبة للغة السامية الأم، لم يتمكن الباحثون من تحديدها بشكل قاطع، ولكنهم توصلوا إلى تحديد خصائصها من خلال مقارنة اللغات السامية التي تشترك في نفس الميزات، مثل الإعراب، والمنع من الصرف، والتعريف بأل، ووجود همزة التعدية، وغيرها من الظواهر اللغوية.
اللغات العربية القديمة
عثر علماء متخصصون في دراسة اللغات السامية على نصوص منقوشة بالخط العربي القديم، تعبر عن لهجات عربية قديمة. تتضمن هذه النقوش ما يلي:
- اللهجة الثمودية: كتبت بالخط المُسند الجنوبي.
- اللهجة اللحيانية: كتبت بالخط المسند الجنوبي.
- اللهجة الصفوية: كتبت بالخط المسند الجنوبي.
- اللهجة النبطية: كتبت بالخط الآرامي.
تستخدم هذه اللغات بعض الظواهر اللغوية الموجودة في اللغة العربية الفصحى، وتعتبر اللهجة النبطية أقرب هذه اللهجات إلى اللغة الفصحى.
المراجع
- شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، صفحة 1- 121- 137. بتصرّف.
- علي الجندي، في تاريخ الأدب الجاهلي، صفحة 102- 111. بتصرّف.
- رواه الدارقطني، في الإلزامات والتتبع، عن كعب بن عاصم الأشعري، الصفحة أو الرقم:109، حديث يلزمهما إخراجه البخاري ومسلم.
- شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، صفحة 1- 104- 111. بتصرّف.
- شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، صفحة 1- 117- 121. بتصرّف.