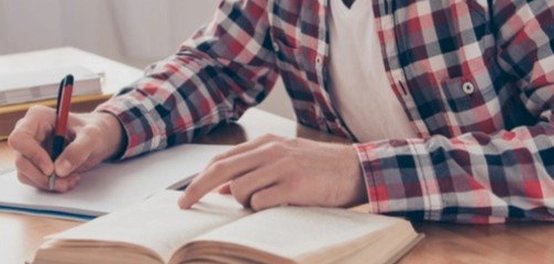مقدمة
تُعد “لا” من الأدوات الهامة في اللغة العربية، وتستخدم لأغراض مختلفة. من بين هذه الاستخدامات، نجد “لا” النافية و”لا” الناهية. فهم الفرق بينهما ضروري لإتقان قواعد اللغة العربية وتجنب الأخطاء اللغوية. هذا المقال سيوضح الفروق الجوهرية بينهما من حيث التعريف، وأنواع الجمل التي تدخل عليها، وتأثيرها على الكلمات التي تليها، والإعراب.
تحديد المعنى
“لا” الناهية الجازمة: هي أداة تستخدم للتعبير عن طلب الامتناع عن فعل شيء ما. تحمل معنى النهي والتحذير من القيام بفعل معين. مثال: “لا تَكذِبْ” (أي: امتنع عن الكذب).
“لا” النافية: هي أداة تستخدم لنفي حدوث فعل أو صفة. تعبر عن عدم وقوع الفعل أو عدم اتصاف الاسم بصفة معينة. مثال: “لا يُسافرُ محمدٌ” (أي: محمد لا يسافر).
وبشكل مختصر، “لا” الناهية تأمر بالكف عن فعل، بينما “لا” النافية تخبر عن عدم وقوعه.
نوع التركيب اللغوي
يختلف نوع الجملة التي تدخل عليها كل من “لا” الناهية و “لا” النافية:
- “لا” الناهية الجازمة: تختص بالدخول على الفعل المضارع فقط. مثال: “لا تَتَهاوَن في واجباتك”.
- “لا” النافية: يمكن أن تدخل على الجمل الاسمية والفعلية على حد سواء.
- في الجملة الفعلية: “لا أَخونُ الأمانة”.
- في الجملة الاسمية: “لا مُهملٌ ناجحٌ”.
شكل الكلمة بعد ‘لا’
يختلف شكل الكلمة التي تأتي بعد “لا” باختلاف نوع “لا”:
- “لا” الناهية الجازمة: تجزم الفعل المضارع الذي يليها. علامة الجزم تختلف حسب نوع الفعل (السكون لل صحيح الآخر، حذف حرف العلة للمعتل الآخر، حذف النون للأفعال الخمسة). مثال: “لا تَقُلْ ما لا تعلمْ”.
- “لا” النافية: لا تؤثر على الفعل المضارع الذي يليها إذا كان مرفوعاً، وإذا دخلت على الجملة الاسمية فلها أحكام مختلفة:
- قد تكون نافية عاملة عمل ليس: “لا مُسافرٌ حاضرًا”.
- قد تكون نافية للجنس عاملة عمل إن: قال تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ} [البقرة: 256].
- قد تكون نافية غير عاملة: “لا الكذبُ محمودٌ”.
التحليل الإعرابي
يختلف الإعراب تبعاً لنوع “لا”:
- إعراب “لا” الناهية: “لا” ناهية جازمة، والفعل المضارع بعدها مجزوم. مثال: “لا تَتَسرَّعْ في الحكم”. (لا: ناهية جازمة، تتسرع: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون).
- إعراب “لا” النافية: يختلف حسب موقعها في الجملة:
- إذا تلاها فعل: نافية لا عمل لها. مثال: “لا يَهْمِلُ الطالبُ دروسه”.
- إذا تلاها جملة اسمية: لها حالات إعرابية مختلفة كما ذكرنا في القسم السابق. مثال: “لا الكَذِبُ مُفيدٌ”.
أمثلة توضيحية
أمثلة من الشعر العربي الفصيح لتوضيح الفرق:
- قال الشاعر: فلا ثوبَ مجْدٍ غير ثوبِ ابن أحمدِ، على أحدٍ إلّا بلُؤمٍ مُرقّعُ
- وقال آخر: مَنْ صدَّ عن نيرانها، فأنا ابنُ قيسٍ لا براحُ
- لا باركَ الله في الغواني هل، يُصبحْنَ إلّا لهنّ مُطّلبُ؟
- يقولون لا تبْعدْ وهمْ يدفنونني، وأينَ مكانُ البعدِ إلّا مكانيا؟
ضوابط للتمييز
للتفريق بين “لا” الناهية و “لا” النافية، يمكن النظر إلى المعنى والسياق:
- “لا” الناهية: تفيد الأمر بالكف عن فعل، وتأتي مع ضمائر المخاطب.
- “لا” النافية: تفيد نفي وقوع الفعل أو الصفة، ويمكن أن تأتي مع ضمائر الغائب والمتكلم.
في قولهم: “لا تحزنْ فالله ناظر” هنالك ثلاث مسائل:
- أفادت لا الأمر بالكفّ عن فعل معيّن:فقد أفادت الطلب، فـ “لا” في الجملة السابقة أفادت الأمر بالكف عن الحزن.
- أتت لا مع الفعل المضارع الذي يحتوي على ضمير المخاطب أو ما ينوب عن ضمائر المخاطب: فالفعل “تحزن” فعل مضارع فاعله أنتَ، وهو من ضمائر المخاطب.
- جزمت لا الفعل المضارع: فالفعل المضارع “تحزنْ” هو فعل مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهرة.
في قولهم: لا رجل في الدّار، لا أراك الله بأسًا، لا يلعب الطفل بالكرة، هنا في الأمثلة السابقة ثَمّ مسائل منها:
- أفادت “لا” النافية نفي أمرٍ ما ولم تُفِد الطلب: ففي الجملة الأولى نفت “لا” وجود الرجل في الدار ولم تنهَه عن ذلك، وفي الجملة الثانية أفاد النفي الدعاء، وفي الجملة الثالثة أفادت “لا” نفي لعب الطفل بالكرة ولم تفِد نهيه عن ذلك أيضًا.
- تكون “لا” التي تسبق الجملة الاسميّة لا نافية: ففي الجملة الأولى جاء بعد “لا” جملة اسميّة، وعليه تكون “لا” نافية.
- تكون “لا” التي تسبق الفعل الماضي لا نافية: ففي الجملة الثّانية جاء بعد “لا” فعلٌ ماضٍ، وعليه تكون “لا” نافية.
- تكون “لا” التي تسبق الفعل المضارع نافية إذا ما كان ضمير الفعل المضارع المتكلّم أو الغائب: ففي الجملة الثالثة جاء بعد “لا” فعل مضارع، وهو “يلعبُ” وضميره عائد على الطفل أي “هو”، وهو من ضمائر الغائب، وعليه تكون “لا” نافية.
تدريبات
لتطبيق الفهم، جرب تحديد نوع “لا” في الجمل التالية:
| الجملة | نوع “لا” | التبرير |
|---|---|---|
| لا رجل في الدار. | نافية | جاء بعدها اسم. |
| لا تقرأْ بصوتٍ مرتفع. | ناهية جازمة | جاء بعدها فعل مضارع مجزوم، وأفادت الطلب، وضمير الفعل المضارع مخاطب “أنتَ”. |
| لا يعملُ الفلّاح في المساء. | نافية | جاء بعدها فعل مضارع غير مجزوم، ولم تفد الطلب، وضمير الفعل المضارع من ضمائر الغائب “هو”. |
| لا قهرٌ مستمرًّا. | نافية | جاء بعدها اسم. |
| لا تقربوا الموبقات. | ناهية جازمة | جاء بعدها فعل مضارع مجزوم، وأفادت الطلب، وضمير الفعل المضارع مخاطب “واو الجماعة”. |
تدريب آخر: أضف “لا” إلى الكلمات التالية مع إجراء التغييرات المناسبة:
| الكلمة | الحل |
|---|---|
| تقنطون | لا تقنطوا |
| بارك | لا بارك |
| تجني | لا تجنِ |
| الطالبُ مجتهدٌ | لا طالبًا مجتهدٌ |
| يعملُ | لا يعملُ |
تدريب أخير: استخرج “لا” الناهية و “لا” النافية من الجمل التالية:
| الجملة | “لا” الناهية | “لا” النافية |
|---|---|---|
| لا قدّر الله فرقتنا | لأنه تلاها فعل ماض. | |
| لا تستمعْ إلى رفقاء السوء | لأنه جاء بعدها فعل مضارع مجزوم، وأفادت الطلب، وضمير الفعل المضارع مخاطب “أنتَ”. | |
| لا رجلَ في الدّار | لأنه جاء بعدها اسم | |
| لا يكذبُ إلّا المذنب | لأنه جاء بعدها فعل مضارع غير مجزوم، ولم تفد الطلب، وضمير الفعل المضارع من ضمائر الغائب “هو”. | |
| لا تتحدثوا أثناء الدّرس | لأنه جاء بعدها فعل مضارع مجزوم، وأفادت الطلب، وضمير الفعل المضارع مخاطب “واو الجماعة”. |
خلاصة
في الختام، يمكن تلخيص الفرق بين “لا” الناهية و “لا” النافية بأن الأولى تفيد طلب الكف عن فعل وتختص بالفعل المضارع المجزوم، بينما الثانية تفيد نفي وقوع الفعل أو الصفة ويمكن أن تدخل على الجمل الاسمية والفعلية. الفهم الدقيق لهذه الفروق يساهم في تحسين مهارات الكتابة والتعبير باللغة العربية.
تنقسم لا إلى نوعين:
فإمّا أن تكون ناهية جازمة وهي التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، وتفيد طلب الكف أو الانتهاء عن فعل أمر معيّن، فعندما يُقال: لا تفعل كذا، فالمراد الأمر بالكفّ عن هذا الفعل المشار إليه، وهي التي ترد قبل المضارع إذا ما أشار الفعل المضارع إلى أحد ضمائر المخاطب “أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتنّ”، أو ما ينوب عنها مثل: واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنّثة المخاطبة أو نون النسوة.
وإمّا أن تكون نافية، وهي التي تفيد نفي حصول أمر معيّن، وهذه الأخيرة أيضًا لها مواضعُ تميّزها عن سابقتها، فهي تأتي مع الأسماء مُطلقًا، فكل تسبق الجمل الاسميّة هي نافية، وكذلك تسبق الفعل الماضي مطلقًا، فكل تسبق الفعل الماضي هي لا نافية، وأمّا مع المضارع فتأتي إذا ما جاء الفعل المضارع مع ضمائر الغائب أو المتكلّم.
المراجع
- أحمد قبّش، الكامل في النحو والصرف والإعراب، دمشق: دار المجد، صفحة 27. بتصرّف.
- ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، بيروت: دار الفكر المعاصر، صفحة 233. بتصرّف.
- مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، بيروت: المكتبة العصرية، صفحة 183، جزء 2. بتصرّف.
- ابن عثيمين، شرح ألفية ابن مالك، صفحة 9، جزء 27. بتصرّف.
- منهاج جامعة المدينة العالمية، أصول النحو، كوالالمبور – ماليزيا: مطبوعات جامعة المدينة العالمية، صفحة 242، جزء 1. بتصرّف.
- مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، بيروت: المكتبة العصرية، صفحة 165، جزء 2. بتصرّف.
- أحمد قبّش، الكامل في النحو والصرف والإعراب، دمشق: دار المجد، صفحة 57. بتصرّف.
- أحمد قبّش، الكامل في النحو والصرف والإعراب، دمشق: دار المجد، صفحة 79. بتصرّف.
- ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، بيروت: دار الفكر المعاصر، صفحة 248. بتصرّف.
- علي بن محمد الهروي، الأُزهية في علم الحروف، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، صفحة 149. بتصرّف.
- الحسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 290. بتصرّف.