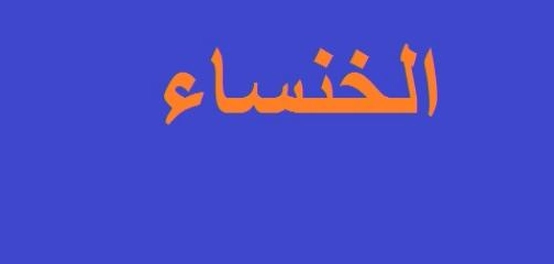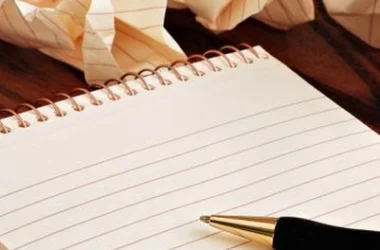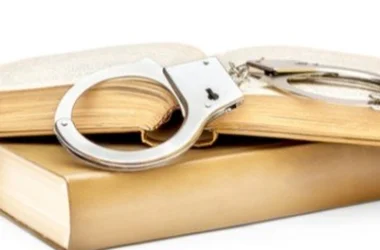نبذة عن حياة الخنساء
هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السُلميّة، شاعرة عربية فصيحة عاشت في الجاهلية وأدركت الإسلام فأسلمت. ولدت في نجد عام 575 ميلاديًا وتوفيت في عام 645 ميلاديًا (24 هجريًا). اشتهرت الخنساء بشعر الرثاء، خاصةً بعد فقدها لأخويها صخر ومعاوية في فترة ما قبل الإسلام. يعود سبب تسميتها بالخنساء إلى صغر وارتفاع أرنبة أنفها.
الخنساء وعلاقتها بإخوتها
تظهر لنا الأحداث التاريخية مدى قوة العلاقة التي جمعت الخنساء بأخويها، حيث كانت حياتها مليئة بالمواقف التي تدل على ذلك. فعندما أراد معاوية إجبارها على الزواج من دريد، التجأت إلى صخر ليحميها ويقف بجانبها، وهو ما فعله بالفعل. وفي موقف آخر، عندما واجهت ضائقة مالية بسبب زوجها عبد العزى، لم تجد سوى صخر ليساعدها، فكان كريمًا معها للغاية وقسم ماله معها مناصفة.
في أحد أيام سوق عكاظ، رأى معاوية بن عمرو أسماء المريّة وأعجب بجمالها، فدعاها لنفسه، لكنها رفضت وأخبرته بأنها زوجة هاشم بن حرملة الغطفاني، سيد العرب. استثار رفضها معاوية، لكن أسماء تحدته وذهبت لتخبر زوجها بما حدث. غضب هاشم وذهب لمعاوية ليسأله عن الأمر، فأقر معاوية بأنه تمنى أن يسمع نائحات يندبنه. بعد انتهاء الموسم، قرر معاوية غزو بني مرة قوم هاشم، لكن صخر نصحه بالعدول عن ذلك، إلا أن معاوية لم يستمع إليه.
خرج معاوية مع فرسان من بني سليم، ولكنهم تطيروا من رؤية الطير والظبي، فرفضوا إكمال المسير. بلغ ذلك هاشم، فاعتبر أن ذلك جبنًا من معاوية. استشاط معاوية غضبًا وخرج في العام التالي مصممًا على الغزو، ولكن أصحابه تطيروا مرة أخرى ورجعوا، ولم يتبعه سوى تسعة عشر فارسًا. علم هاشم بوجود معاوية في المنطقة، فخرج مع أخيه دريد وجمع من قومه، وتمكنوا من قتل معاوية. عاد فرسان بني سليم إلى صخر ظانين أنهم انتقموا لأجله، لكن صخر لم يرضَ بذلك، وذهب بنفسه إلى بني مرة ليسألهم عن قاتل معاوية. بعد صمت طويل، أجاب هاشم بأنه إذا قتل صخر هاشم أو أخاه دريد، فإنه سينتقم لأخيه. سأل صخر عما إذا كانوا قد كفنوا معاوية، فأجابوا بالإيجاب وأروه قبره، فتأثر صخر ولكنه تمالك نفسه وقال: “كأنّكم قد أنكرتم ما رأيتم من جزعي، فوالله مابِتُّ منذ عقلت إلا باتراً أو مبترواً، طالباً أو مطلوباً، حتّى قُتِل معاوية، فما ذقت طعم نوم بعده”.
ثم سأل عن فرس معاوية الشماء، فأحضروها له، وتوعدهم صخر بالعودة في العام المقبل. وبالفعل، غزاهم صخر على الشماء وأنزل بهم خسائر فادحة وقتل دريد. لم تترك بنو غطفان صخرًا، فخرجوا في أثره، ولكن ابن اخته العباس بن مرداس حماه حتى وصل إلى ديار بني سليم. وعندما طلب منه أحدهم أن يهجوهم، أجاب:
تقول ألا تهجو فوارس هاشم
ومالي إذ أهجوهم ثمّ ماليا!
أبى الشّتم أنّي قد أصابوا كريمتي
وأن ليس إهداء الخنا من شماليا
إذا ما امرؤ أهدى لميت تحية
فحياك ربّ النّاس عنّي معاويا
وهون وجدي أنّني لم أقل له
كذبت، ولم أبخل عليه بماليا
الخنساء وفن الرثاء
يرى بعض النقاد أن شعر الخنساء في رثاء معاوية أقل من شعرها في رثاء صخر، ويرجعون ذلك إلى الصدمة المفاجئة التي تلقتها، أو خوفها على صخر من أن يدفعه شعرها إلى حتفه. لكن بالنظر إلى عادات العرب وتقاليدهم في الرثاء، نجد أن الأمر طبيعي، حيث كانوا يأنفون من البكاء على من مات في المعركة، ويعتبرون ذلك هجاءً له. لذا، كان رثاؤهم عبارة عن تأبين يذكر فضائل المقتول ومكانته في قبيلته. لذلك، عاب البعض على الخنساء في مراثي معاوية خلوها من البكاء، ومن ذلك قولها:
ألا لا أرى في النَّاسِ مثلَ معاويهْ
إذا طَرَقَتْ إحْدَى اللّيالي بِداهِيَهْ
بداهِيَة ٍ يَصْغَى الكِلابُ حَسيسَها
وتخرُجُ منْ سِرّ النّجيّ عَلانِيَهْ
ألا لا أرى كالفارسِ الوردِ فارساً
إذا ما عَلَتْهُ جُرْأة ٌ وعَلانِيَهْ
وكانَ لِزازَ الحَرْبِ عندَ شُبوبِها
إذا شمَّرتْ عنْ ساقها وهي ذاكيهْ
وقوَّادُ خيلٍ نحو أُخرى كانَّها
سَعالٍ وعِقْبانٌ عَلَيْها زَبانِيَهْ
بُلينا وما تبلى تعارٌ وما ترى
على حدثِ الايَّامِ إلاَّ كماهيهْ
فأقسَمْتُ لا يَنفَكّ دمعي وعَوْلَتيعليكَ بحزنٍ ما دعا اللهَ داعيهْبلينا وما تبلى تعار وما ترىعلى حدث الأيام إلّا كما هيه
وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن تجاهل الحزن الذي عانته الخنساء بعد فقد معاوية، سواء كبتت أحزانها خوفًا على صخر، أو أجبرتها تقاليد قومها على السكوت. لم يرض صخر بالثأر لمعاوية من دريد، فتابع غاراته على مرة حتى أصيب بجرح قاتل. مرض صخر لمدة عام، وتدهورت حالته حتى قالت زوجته: “بشرٌ حال، لا حيّ فيرجى، ولا ميت فيُنعى”. وعندما سألت تماضر عن حاله، أجابها صخر:
أرى أمَّ صخرٍ ما تجفُّ دموعُها
وملَّتْ سُليمى مَضْجعي ومكانيفأّيُّ امرئٍ ساوى بأمٍ حليلةًفلا عاشَ إِلا في شقاً وهوانِ
وبعد معاناة طويلة، مات صخر في يوم كلاب عام 615 ميلاديًا. انهارت الخنساء بعد موت صخر، ولم تستطع أن تتمالك نفسها، فقد فقدت عزها ومؤنسها وحاميها. أقامت على قبره زمانًا تبكيه وتندبه وترثيه.
في يوم من الأيام، طلب من الخنساء أن تصف أخويها، فقالت: “إن صخرًا كان الزّمان الأغبر، وذعاف الخميس الأحمر، وكان معاوية القائل الفاعل”. وعندما سئلت أيهما كان أسنى وأفخر، أجابت: “صخر حرّ الشتاء، ومعاوية برد الهواء”. وسئلت أيهما أوجع وأفجع، فقالت: “أما صخر فجمر الكبد، وأما معاوية فسقام الجسد”.
قيل أن موت صخر كان تاريخ ميلاد شاعرة العرب، نظرًا لكثرة ما قالت فيه. كانت الخنساء تعلن عن مصيبتها بفقد أخويها في المواسم، وتقول: “أنا أعظم العرب مصيبةً”، فيقر لها الناس بذلك.
لم يكن أمام الخنساء بعد موت صخر سوى أن تعلن عن حزنها ويأسها، وأن تترك لدمعها يناجيها، وفي ذلك السلوى والراحة لها. وقد أقر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: “دعوها، فإنّها لا تزال حزينة أبداً”.
وقد اجتمعت للخنساء في مراثيها أنواع الرثاء الثلاثة، نسمعها نادية باكية، يرتفع نشيجها فيثير الأشجان، ويُجري الدّموع من المآقي، وذلك إذ تقول:
أبنت صخر تلكم الباكية
لا باكي اللّيلة إلا هيهوتقول:يا عينِ جودي بالدّموعِ الغِزَارْوأبكي على أروعَ حامِي الذّمارْفرعٍ منَ القومِ الجدىأنْماهُ منهُمْ كلُّ محضِ النِّجارْأقولُ لمّا جاءَني هُلْكُهُوصرَّحَ النَّاسُ بنجوى السّرارْأُخَيّ! إمّا تَكُ وَدّعْتَنَافَرْعٍ منَ القَوْمِ كريمِ الجَدافرُبّ عُرْفٍ كنْتَ أسْدَيتَهُإلى عيالٍ ويتامى صغارْوربَّ نعمى منكَ أنعمتهاعلى عُناة ٍ غُلَّقٍ في الإسارْأهْلي فِداءٌ للّذي غُودِرَتْأعْظُمُهُ تَلْمَعُ بَينَ الخَبارْصَريعِ أرْماحٍ ومَشْحوذَةكالبرقِ يلمعنَ خلالَ الدّيارْمَنْ كانَ يَوْماً باكياً سَيّداًفليبكهِ بالعبراتِ الحرارْولتبكهِ الخيلُ إذا غودرتْبساحة ِ الموتِ غداة َالعثارْوليبكهِ كلُّ أخي كربةضاقتْ عليهِ ساحة ُ المستجارْرَبيعُ هُلاّكٍ ومأوى نَدًىحينَ يخافُ النَّاسُ قحطَ القطارْأسْقَى بِلاداً ضُمّنَتْ قَبْرَهُصَوْبُ مَرابيعِ الغُيوثِ السَّوارْوما سؤالي ذاكَ الاَّ لكييسقاهُ هامٍ بالرَّوي في القفارْقُلْ للّذي أضْحَى بهِ شامِتاًإنّكَ والموْتَ، مَعاً، في شِعارْ
وتقول:
بَكَت عَيني وَعاوَدَها قَذاها
بِعُوّارٍ فَما تَقضي كَراها
على صَخرٍ وَأَيُّ فَتىً كَصَخرٍ
إِذا ما النّابُ لَم تَرأَم طِلاها
فَتى الفِتيانِ ما بَلَغوا مَداهُ
وَلا يَكدى إِذا بَلَغَت كُداها
حَلَفتُ بِرَبِّ صُهبٍ مُعمِلاتٍ
إِلى البَيتِ المُحَرَّمِ مُنتَهاهالَئِن جَزِعَت بَنو عَمروٍ عَلَيهِلَقَد رُزِئَت بَنو عَمروٍ فَتاهالَهُ كَفٌّ يُشَدُّ بِها وَكَفٌّتَحَلَّبُ ما يَجِفُّ ثَرى نَداهاتَرى الشُمَّ الجَحاجِحَ مِن سُلَيمٍيَبُلُّ نَدى مَدامِعِها لِحاهاعَلى رَجُلٍ كَريمِ الخيمِ أَضحىبِبَطنِ حَفيرَةٍ صَخِبٍ صَداهالِيَبكِ الخَيرَ صَخراً مِن مَعَدٍّذَوُو أَحلامِها وَذَوُو نُهاها
وقد أجمع أهل العلم بالشّعر أنّه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها.
أنشدت في سوق عكاظ بين يدي النّابغة الذّبياني، وحسّان بن ثابت رائيّتها التي رثت بها صخر:
قذى بعينكِ أمْ بالعينِ عوَّارُ
أمْ ذرَّفتْ أخلتْ منْ أهلهَا الدَّارُ
كأنّ عيني لذكراهُ إذا خَطَرَتْفيضٌ يسيلُ علَى الخدَّينِ مدرارُتبكي لصخرٍ هي العبرَى وَقدْ ولهتْوَدونهُ منْ جديدِ التُّربِ استارُتبكي خناسٌ فما تنفكُّ مَا عمرتْلها علَيْهِ رَنينٌ وهيَ مِفْتارُتبكي خناسٌ علَى صخرٍ وحقَّ لهَاإذْ رابهَا الدَّهرُ أنَّ الدَّهرَ ضرَّارُلاَ بدَّ منْ ميتة ٍ في صرفهَا عبرٌوَالدَّهرُ في صرفهِ حولٌ وَأطوارُقدْ كانَ فيكمْ أبو عمرٍو يسودكمُنِعْمَ المُعَمَّمُ للدّاعينَ نَصّارُصلبُ النَّحيزة ِ وَهَّابٌ اذَا منعُواوفي الحروبِ جريءُ الصّدْرِ مِهصَارُيا صَخْرُ وَرّادَ ماءٍ قد تَناذرَهُأهلُ الموارِدِ ما في وِرْدِهِ عارُمشَى السّبَنْتى إلى هيجاءَ مُعْضِلَةلهُ سلاحانِ: أنيابٌ وأظفارُوما عَجُولٌ على بَوٍّ تُطيفُ بِهِلها حَنينانِ: إعْلانٌ وإسْرارُتَرْتَعُ ما رَتَعَتْ، حتّى إذا ادّكرَتْفانَّما هيَ إقبالٌ وَإدبارُلاَ تسمنُ الدَّهرَ في أرضٍ وَانْ،رتعتْ فإنَّما هيَ تحنانٌ وَتسجارُيوْماً بأوْجَدَ منّي يوْمَ فارَقنيصخرٌ وَللدَّهرِ أحلاءٌ وَأمرارُوإنّ صَخراً لَوالِينا وسيّدُناوإنّ صَخراً إذا نَشْتو لَنَحّارُ
المصادر
- جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، أحمد الهاشمي، المكتبة التّجارية الكبرى، الجزء الأول، ص127-128 بتصرّف.
- العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، تحقيق مفيد محمد قميحة، دار إحياء التراث العربي، 1983، المجلد السادس، ص28 بتصرّف.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق عادل مرشد، دار الأعلام، 2002، الجزء الأول، صفحة 590 بتصرّف.
- الأغاني، الأصفهاني، دار الكتب، الجزء الأول، ص251 بتصرّف.
- أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: حياتهم – آثارهم – نقد آثارهم، بطرس البستاني، الطبعة السادسة، مكتبة صادر – بيروت، ص229 بتصرّف.
- أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: حياتهم – آثارهم – نقد آثارهم، بطرس البستاني، الطبعة السادسة، مكتبة صادر – بيروت، ص223 بتصرّف.