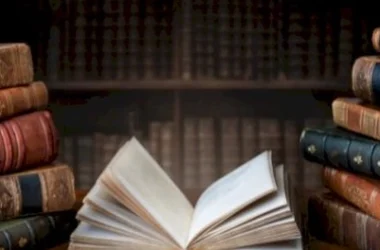المرابطون في الحقبة الأندلسية
في ظلّ التدهور والانقسامات التي عصفت بملوك الطوائف في الأندلس، ومع استمرار الهجمات الإسبانية المسيحية التي هدفت إلى إضعاف الأندلس واستنزاف مواردها، بلغ الأمر ذروته بسقوط مدينة طليطلة سنة 1085م. عندها، اتجهت الأنظار نحو قوة قادرة على إعادة الاستقرار إلى الأندلس. فتمّ طلب النجدة من المرابطين، واستجاب قائدهم يوسف بن تاشفين لهذا النداء، وعبر إلى الأندلس للجهاد في سبيل الله.
تكرر طلب العون من المرابطين مرة أخرى من قبل المعتمد بن عبّاد لإنقاذ الأندلس من هذا الضعف الشديد. كان الأندلسيون يعيشون في حالة من الذل والاستسلام لأكثر من سبعين عامًا، ولكن هذا الوضع تغير عندما تعرفوا على المرابطين. فقد خاضوا معهم معارك لإعلاء كلمة الله، وتغيرت نفوسهم وأحوالهم، وذلك بفضل سبعة آلاف رجل فقط، مما أدى إلى إحياء العزة والكرامة في نفوس الناس تجاه دينهم.
بعد عودة ابن تاشفين إلى المغرب، تجدد الخلاف وساءت أحوال الطوائف مرة أخرى. فوصلت الرسائل والكتب من مسلمي الأندلس، وكذلك من علماء وفقهاء المشرق، إلى يوسف بن تاشفين – للمرة الثالثة – مطالبين بالنجدة والنصرة. فاستجاب للنداء وعبر الأندلس سنة 1090م، وتوجه نحو طليطلة عاصمة قشتالة. ولكنه عندما رأى تحصيناتها القوية، تركها وتوجه نحو غرناطة حيث استقبله أميرها عبد الله بن بلقين، ثم عاد بعدها إلى المغرب.
على الرغم من عودته، إلا أنه ترك بعضًا من قادته لاستكمال مهمته في عزل ملوك الطوائف. وبعد خضوع قرطبة، خاض المرابطون معارك عديدة مع ألفونس السادس، وبذلوا جهودًا كبيرة في استعادة بلنسية من القمبيطور والقشتاليين. ثم كانت عودة ابن تاشفين الرابعة إلى الأندلس سنة 1096م. وفي عام 1101م تمت البيعة لابنه أبي الحسن علي، واشترط فيها إنشاء جيش مرابطي دائم.
بداية ظهور المرابطين
انطلقت حركة المرابطين مع أحداث “بربشتر” و”بلنسية” في عام 440هـ/1048م، من قلب الصحراء الموريتانية، في الجنوب القاحل حيث الحر الشديد والفقر والبداوة. في هذه الصحراء الشاسعة، كانت تعيش قبائل الأمازيغ، ومنها قبيلة “صنهاجة” الكبيرة، وكانت قبيلتا “جُدالة ولَمْتُونة” من أكبر قبائل “صنهاجة”، وكان على رأس “جُدالة” يحيى بن إبراهيم الجُدالي، صاحب الخلق الحسن.
تقع هذه القبيلة جنوب موريتانيا، وقد دخلت الإسلام منذ زمن بعيد. انتبه يحيى إلى أحوال قبيلته فوجدها غارقة في الضلال والعبث، فقد انتشر الزنا، وأقبل الكثيرون على شرب الخمر، ورأى أن الرجل يتزوج بأكثر من أربع نساء، والمسلمون يرون ذلك ولا ينكرونه، فتشتت القبائل وكثر السلب والنهب، فكان الوضع أسوأ مما حدث في دويلات الطوائف.
لم يكن يحيى بن إبراهيم الجُدالي قادرًا على تغيير ما في قومه، فهدَاه الله إلى الحج. وأثناء عودته، تعرف على أبي عمران موسى بن عيسى الفاسي (شيخ المالكية في مدينة قيروان)، فأرسل معه أبو عمران شيخًا جليلًا يُفقّه الناس في دينهم، فكان عبد الله بن ياسين، الزعيم الأول للمرابطين، وصاحب الدعوة الإصلاحية فيهم، فبدأ بتعليم الناس، وردّهم عن طغيانهم.
شيئًا فشيئًا بدأ الناس يستجيبون له بعد تحديات شديدة واجهته، وقام على ترسيخ المفاهيم الإسلامية الصحيحة في نفوسهم، وتقويتهم فكريًا وجسديًا. وبعد استشهاده –رحمه الله- تولّى الشيخ “أبو بكر بن عمر اللمتوني” زعامة المرابطين، وخلال سنتين من زعامته ظهر في التاريخ ما يعرف بدويلة المرابطين، شمال السنغال وجنوب موريتانيا، ومن بعده تولّى المسؤولية يوسف بن تاشفين، فكان محبًا وداعيًا لدينه.
أسباب أفول دولة المرابطين
وكما هي سنة الحياة، فدوام الحال من المحال، ضعفت دولة المرابطين لأسباب ما زلنا نشهدها، ويمكن إجمالها فيما يلي:
- فتنة الدنيا وإن استمر الجهاد.
- جدال عظيم عقيم بين العلماء والعامة.
- كثرة الذنوب بالرغم من وجود العلماء.
- الأزمات الاقتصادية التي تعرضوا لها.
أصل كلمة المرابطين:
الرّباطُ ما يُربط به، جمع رَبطة وأربطة ورباطات ورُبُط، والرّباط: الخيل نفسها، والرّباطُ من الخيل أي الخمسون فما فوقها، وهي موضع المرابطة مثل الحِصْن وغيره يُقيم فيه الجيش، ورابَطَ الرّجل في المكان: أقام فيه ولم يُغادرْه، وعن الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (رِباطُ يَومٍ في سَبيلٍ الله خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا).
فالرباط هو ملازمة الجهاد، وهكذا كان المرابطون أو المجاهدون في اتّخاذهم الخيام حِصنًا يَحمون فيها ثغور المسلمين، ويُطلق عليهم مصطلح الملثّمين فيُقال أمير الملثّمين ودولة الملثّمين، لأنّهم قوم يَتلثّمون ولا يَكشفون وجوههم كما ذُكر عند ابن خلّكان في وفيات الأعيان.
المصادر
- أبتمحمد علي طقوس،”المرابطون في الأندلس 1086م – 1146م”،مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، اطّلع عليه بتاريخ 11/2/2022. بتصرّف.
- أبتثجحخراغب السرجاني (1/5/2006)،”دولة المرابطين”،قصة الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 11/2/2022. بتصرّف.
- “تعريف و معنى رباط في معجم المعاني الجامع”،المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 11/2/2022. بتصرّف.
- رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن سهل بن سعد الساعدي، الصفحة أو الرقم:2892 ، حديث صحيح.