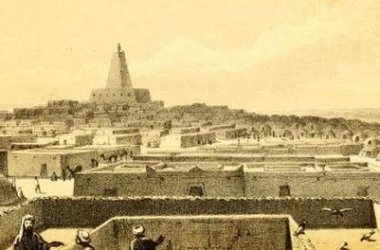مقدمة
تعتبر الفلاحة من الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، فهي ليست مجرد نشاط تقليدي، بل هي قطاع حيوي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة. في هذا المقال، سنستعرض أهم جوانب الفلاحة في تونس، بدءًا بأهميتها الاقتصادية، مرورًا بالعوامل المؤثرة عليها، وصولًا إلى أبرز المحاصيل الزراعية والتوجهات الحديثة في هذا القطاع.
أهمية القطاع الزراعي للاقتصاد
يشكل القطاع الفلاحي ركيزة أساسية في اقتصاد تونس، حيث يساهم بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2021، بلغت مساهمة الفلاحة مع قطاعي الغابات والصيد البحري حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.[1] كما يعتبر هذا القطاع مصدراً هاماً للعمالة، إذ يوفر فرص عمل لحوالي 16% من القوى العاملة في البلاد، مع ملاحظة أن النساء يمثلن نسبة كبيرة تصل إلى 50% من العاملين في هذا القطاع.[2]
تلعب المنتجات الفلاحية دوراً هاماً في الصادرات التونسية، حيث تمثل حوالي 6% من إجمالي الصادرات. من بين أهم المحاصيل الزراعية في تونس، نجد القمح والشعير، بالإضافة إلى التمور والزيتون والفواكه الطازجة التي يتم إنتاجها للتصدير والاستهلاك المحلي. يعتبر زيت الزيتون المنتج الفلاحي الرئيسي الذي يتم تصديره.[2]
المؤثرات الرئيسية على الإنتاج الزراعي
يعتمد القطاع الفلاحي في تونس بشكل كبير على الموارد المائية المتاحة. تواجه البلاد تحديات كبيرة بسبب المناخ الجاف وشبه الجاف الذي يغطي أكثر من ثلاثة أرباع مساحتها، وذلك نتيجة لقلة الأمطار ومحدودية الموارد المائية المتجددة. يستهلك القطاع الفلاحي أكثر من 75% من إجمالي استخدام المياه في البلاد.[2]
تعتبر التغيرات المناخية من أبرز العوامل التي تؤثر على الإنتاج الفلاحي، حيث تتسبب في تقلبات كبيرة في كميات الإنتاج من عام لآخر. بالإضافة إلى ذلك، يواجه القطاع تحديات أخرى مثل تقدم المزارعين في العمر، وتدهور الموارد الطبيعية مثل خصوبة التربة، وتجزئة الأراضي الزراعية.[2]
الأراضي المتاحة للزراعة
تبلغ نسبة الأراضي التونسية الصالحة للزراعة حوالي 30% من إجمالي مساحة البلاد، بينما تمثل الأراضي غير الصالحة للزراعة نسبة 43%. أما النسبة المتبقية البالغة 27% من المساحة الكلية التي تقدر بـ 101,662 كيلومتر مربع، فتتوزع بين المراعي والغابات.[3]
أهم المحاصيل الزراعية
تغطي الحبوب والمحاصيل الشجرية حوالي 87% من مساحة الأراضي المزروعة في تونس. تتوزع هذه المساحة على النحو التالي: 43% للحبوب، حيث تتركز زراعتها في المناطق الشمالية بنسبة 47% وفي الأجزاء الوسطى والجنوبية بنسبة 53%. أما المحاصيل الشجرية فتمثل نسبة 44%، وتتركز بشكل أساسي على زراعة الزيتون، بالإضافة إلى زراعة التمر واللوز والفستق والكمثرى والتفاح والعنب في عدد من المزارع.[3]
تتوزع الأراضي الزراعية التونسية بين المحاصيل المختلفة، حيثُ تتواجد أراضي المحاصيل الشجرية بمعدل 87% في وسط تونس والجنوب، وما تبقى من الأراضي وبنسبة 17% تتوزع ما بين 7% محاصيل العلف، و3% محاصيل الخضراوات، و2.5% البقوليات، وبنسبة 0.5% محاصيل أخرى مختلفة.[3]
الزراعة الإيكولوجية
تعتبر الزراعة الإيكولوجية اتجاهًا حديثًا نسبيًا في تونس، وقد شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. ازدادت مساحة الأراضي المخصصة للزراعة العضوية وأعداد المزارعين الذين يتبنون هذا النهج، لتشكل نسبة جيدة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية. تمتلك تونس أحد أكبر القطاعات العضوية وأكثرها تطورًا في قارة إفريقيا.[4]
تخصص حوالي ثلاثة أرباع الأراضي العضوية لزراعة الزيتون، بالإضافة إلى محاصيل أخرى مثل التمور واللوز والفواكه والخضروات والجوجوبا والعسل والنباتات العطرية. ومن النظم الزراعية التقليدية المستخدمة في بحيرات غار الملح وحدائقها المعلقة من جبة العليا ما يأتي:[5]
الزراعة الرملية
تعتمد الممارسات الزراعية الرملية في غار الملح بشكل أساسي على الركائز الرملية، وهي تقنية مستخدمة في جميع أنحاء العالم. تعتمد هذه التقنية على نظام الري السلبي، حيث تتم تغذية جذور النباتات في كل موسم بمياه الأمطار من خلال حركة المد والجزر. يتم الحفاظ على قطع الأراضي في البحيرة من خلال إمدادها بالرمل والمواد العضوية.[5]
الحدائق المعلقة
توجد الحدائق على مرتفعات جبل الجورة، وتشكل نظامًا للزراعة الحرجية على ارتفاع 600 م.[5]