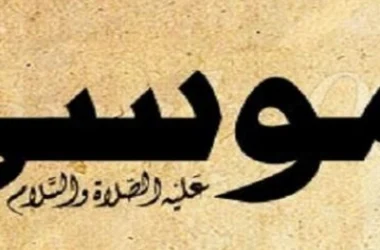مقدمة
علم التجويد هو العلم الذي يهتم بإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح مع إعطائه حقه ومستحقه من الصفات. ومن بين الأحكام التجويدية التي يحسن بالمسلم معرفتها، الروم والإشمام، فهما طريقتان من طرق الوقف على أواخر الكلمات في القرآن الكريم. يهدف هذا المقال إلى توضيح مفهوم كل منهما وبيان الفروق الجوهرية بينهما.
تعريف الروم والإشمام
الروم في اللغة: يعني الابتغاء والطلب. وفي الاصطلاح: هو الإتيان بثلث الحركة بصوت منخفض لا يسمعه إلا القريب، ويسمعه الأعمى إذا كان قريبًا، بينما لا يدركه الأصم حتى لو كان مبصرًا. ويقع الروم في الحركات المضمومة والمرفوعة، وكذلك المكسورة والمجرورة.
أما الإشمام: فهو عبارة عن ضم الشفتين بعد النطق بالحرف الأخير ساكنًا، وهو حركة مرئية وليست مسموعة، وتكون بدون صوت إطلاقًا، ويكون شكل الشفتين كمن يهم بالضم. يدركه المبصر حتى لو كان أصم، بينما لا يدركه الأعمى أبدًا، ويقع الإشمام فقط في الحركات المضمومة والمرفوعة.
أوجه الاختلاف بين الروم والإشمام
يعتبر الروم والإشمام من الأحكام المتعلقة بالوقف على الكلمات القرآنية، ويهدفان إلى الإشارة إلى حركة الحرف الأخير من الكلمة بعد النطق به ساكنًا. وهناك عدة اختلافات جوهرية بينهما، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
من ناحية الحركة
الروم يكون في الحركات الأربعة: المضموم، والمرفوع، والمكسور، والمجرور. بينما الإشمام يقتصر على المرفوع والمضموم فقط، ولا يكون في المكسور أو المجرور.
من ناحية الوصل والوقف
الروم يشبه الوصل في بعض الأحكام؛ حيث يتم مراعاة أحكام وصفات الحرف من تفخيم وترقيق وغير ذلك كما في حالة الوصل. بينما الإشمام يعامل معاملة الوقف؛ حيث يتم مراعاة أحكام وصفات الحرف من تفخيم وترقيق وغير ذلك كما في حالة الوقف.
من حيث الكيفية
الروم هو عبارة عن صوت مسموع، حيث يسمعه الأعمى ولا يراه، ولا يدركه الأصم. أما الإشمام فهو هيئة مرئية، حيث يراه الأصم ولا يسمعه، ولا يدركه الأعمى. إذن، الروم هو هيئة مسموعة وغير مرئية، بينما الإشمام هو هيئة مرئية وغير مسموعة.
الغرض من الروم والإشمام
تكمن فائدة الروم والإشمام في إعلام السامع والبصير بحركة الحرف الموقوف عليه. فالروم يظهر للسامع، والإشمام يظهر للبصير. ولهذه الأحكام أهمية خاصة في حالة الجمع بين القراءات المختلفة، فعلى سبيل المثال، عند القراءة برواية عاصم والجمع بين روايتي حفص وشعبة. ومع ذلك، لا يمكن تعلم الروم والإشمام إلا بالتلقي المباشر من الشيوخ والعلماء المتخصصين. ومن يقرأ منفردًا فليس عليه روم ولا إشمام، إلا في كلمة واحدة وهي (تأمنا).
وأصل هذه الكلمة هو (تأمننا)، وفيها وجهان: الإشمام، والروم؛ أي الإتيان بثلث حركة النون الأولى، وهذه الكلمة الوحيدة التي جاء بها الروم والإشمام في وسطها، وفي غير هذه الكلمة لا يكون الروم والإشمام إلا على الحرف الأخير من الكلمة. ففي قوله تعالى: قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ
[يوسف: 11]
مواضع الاستثناء من الروم والإشمام
هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها تطبيق الروم والإشمام، وهي:
- ما كان ساكنًا أصليًا في حالة الوصل، مثل (فلا تنهرْ).
- ما كان متحركًا بالفتح غير المنون في حالة الوصل، مثل (لا ريبَ)، وذلك لأن الفتحة خفيفة وإذا ذهب جزء منها ذهب كلها، ولا تقبل التبعيض، بينما الروم هو الإتيان بجزء من الحركة.
- هاء التأنيث المبدلة من التاء في حالة الوقف، مثل (جنة)، حيث تذهب حركة التاء عند إبدالها، والغرض من الروم والإشمام هو بيان حركة الحرف الموقوف عليه.
- ميم الجمع سواء كانت متحركة أو غير متحركة، لأن حركتها تكون عارضة لمنع التقاء الساكنين، مثل (عليهم).
- ما كانت حركته عارضة، أي غير أصلية، إما للنقل مثل (منِ استرق)، وإما لمنع التقاء الساكنين مثل (قمِ الليل)، فهذه الحركات تعود إلى أصلها وهو السكون في حالة الوقف.
المراجع
- خالد الجريسي، معلم التجويد، صفحة 140-141. بتصرّف.
- فريال زكريا العبد، الميزان في أحكام تجويد القرآن، صفحة 220. بتصرّف.
- مجموعة من المؤلفين، أرشيف ملتقى أهل المفسرين. بتصرّف.