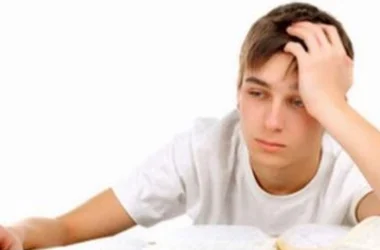مقدمة حول ألفا ثلاسيميا
يُعد مرض الثلاسيميا اضطراباً دموياً وراثياً ينتقل من الآباء إلى الأبناء. يؤثر هذا المرض في قدرة الجسم على إنتاج الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
ينقسم الثلاسيميا إلى نوعين رئيسيين: ألفا ثلاسيميا وبيتا ثلاسيميا. ألفا ثلاسيميا تنتج بسبب خلل في إنتاج سلسلة ألفا غلوبين من الهيموغلوبين.
ينتشر ألفا ثلاسيميا بشكل خاص في مناطق مثل الشرق الأوسط، وحوض البحر الأبيض المتوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا.
الكشف عن ألفا ثلاسيميا
غالباً لا تظهر أعراض على حاملي مرض الثلاسيميا، وقد لا يعلمون بحملهم للمرض إلا عند إجراء فحوصات ما قبل الزواج أو بعد ولادة طفل مصاب. في المقابل، يتم تشخيص المرض لدى المصابين خلال السنتين الأوليين من العمر، حيث تظهر عليهم أعراض تتراوح بين المتوسطة والشديدة. للكشف عن الإصابة أو الحمل بالمرض، يمكن إجراء عدة فحوصات دموية، من ضمنها:
- العد الدموي الشامل: يساعد هذا الفحص في تحديد حجم وعدد كريات الدم الحمراء، بالإضافة إلى قياس مستويات الهيموغلوبين في الدم.
- فحص عدد الخلايا الشبكية: يحدد هذا الفحص مدى سرعة إنتاج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظم عن طريق قياس عدد الخلايا الشبكية (خلايا الدم الحمراء غير الناضجة) في الدم. تمثل الخلايا الشبكية عادةً 1-2% من إجمالي خلايا الدم الحمراء، وتستغرق حوالي يومين لتنضج وتتحول إلى كريات دم حمراء.
- فحص الحديد: يساعد هذا الفحص الطبيب في تحديد سبب فقر الدم، حيث لا يكون هناك نقص في مستوى الحديد في حالة الثلاسيميا.
- فحوصات جينية: تتضمن هذه الفحوصات تحليل الحمض النووي (DNA) للتحقق من وجود أي خلل في الجينات.
-
فحوصات ما قبل الولادة: يمكن الكشف عن وجود مرض الثلاسيميا لدى الجنين قبل الولادة باستخدام:
- فحص الزغابات المشيمية: يتم إجراؤه في الأسبوع الحادي عشر من الحمل، ويشمل أخذ عينة من المشيمة للفحص.
- بزل السلى: يتم إجراؤه خلال الأسبوع السادس عشر من الحمل، ويشمل أخذ عينة من السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين.
أصناف ألفا ثلاسيميا
تصنف أنواع ألفا ثلاسيميا بناءً على عدد الجينات المتأثرة (المفقودة أو التي تحمل طفرات) المسؤولة عن إنتاج ألفا غلوبين. تشمل هذه الأنواع:
- حامل ألفا ثلاسيميا الصامت: في هذه الحالة، يكون هناك خلل في جين واحد فقط من جينات ألفا غلوبين. لا تظهر على حامل هذا النوع أعراض، ولكنه قادر على نقل المرض إلى أبنائه.
- ألفا ثلاسيميا الصغرى: هنا، تكون المشكلة في جينين من جينات ألفا غلوبين. غالباً لا تظهر أعراض على المصاب، ولكنه قد ينقل المرض إلى أولاده. قد يعاني المصاب من صغر حجم خلايا الدم الحمراء وفقر دم خفيف في بعض الأحيان.
- داء الهيموغلوبين إتش: في هذه الحالة، تكون المشكلة في ثلاثة جينات. يعاني المريض من فقر دم بسيط أو متوسط، وتضخم الكبد والطحال، واصفرار العيون والجلد (اليرقان). قد يتأثر العظم أيضاً، مما يؤدي إلى زيادة نمو الفك العلوي وبروز الجبين.
- ألفا ثلاسيميا الكبرى: تُعرف أيضاً بمتلازمة هيموغلوبين بارت. تحدث اضطرابات في جميع الجينات المسؤولة عن تكوين ألفا غلوبين. تُعتبر هذه الحالة الأخطر، حيث تسبب مشاكل صحية عديدة مثل تجمع السوائل في جسم الجنين، فقر دم شديد، تضخم الكبد والطحال، مشاكل في القلب، وتشوهات في الجهاز البولي أو الأعضاء التناسلية. غالباً ما تؤدي هذه المتلازمة إلى وفاة الطفل قبل الولادة أو بعدها بوقت قصير، بالإضافة إلى تأثيرات خطيرة على الأم الحامل مثل تسمم الحمل.
العلامات المصاحبة لألفا ثلاسيميا
تختلف الأعراض الظاهرة على المريض حسب نوع ألفا ثلاسيميا ودرجة خطورته. بشكل عام، يعاني المصابون من انخفاض في نسبة الهيموغلوبين الطبيعي، مما يقلل من وصول الأكسجين إلى الأنسجة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي نقص عدد كريات الدم الحمراء إلى فقر الدم. تشمل الأعراض الشائعة شحوب الوجه، الضعف والتعب، الإرهاق، وضيق التنفس. قد تظهر أعراض أخرى مثل بطء النمو، تشوهات في عظام الوجه، انتفاخ البطن، وتغير لون البول ليصبح أغمق.
سبل التعامل مع ألفا ثلاسيميا
الأنواع البسيطة من ألفا ثلاسيميا (حامل ألفا ثلاسيميا الصامت وألفا ثلاسيميا الصغرى) غالباً لا تتطلب علاجاً، حيث يكون فقر الدم بسيطاً ولا يشكل خطراً حقيقياً على الصحة. العلاج يكون ضرورياً في الحالات الصعبة من ألفا ثلاسيميا. تشمل طرق العلاج:
- داء الهيموغلوبين إتش: في بعض الحالات، خاصة عند حدوث نوبة انحلال الدم أو نوبة انعدام التنسج، يتم العلاج عن طريق نقل كريات الدم الحمراء للمريض. نادراً ما يتم علاج هذا النوع من ألفا ثلاسيميا بنقل الدم في الحالات التي لا يعاني فيها المصاب من هذه النوبات، وإنما يقتصر على فقر الدم الشديد الذي يؤثر سلباً في العمليات الحيوية مثل عمل القلب، ونمو وزيادة خلايا الدم الحمراء، وحدوث تغييرات كبيرة في العظام.
- متلازمة هيموغلوبين بارت: يمكن إنقاذ حياة الطفل المصاب بهذه المتلازمة عن طريق نقل الدم، خاصة أثناء وجوده في الرحم. قد تكون هناك حاجة نادرة لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم للحفاظ على حياة المريض.
المصادر
- Robin E. Miller (1-7-2015), “Alpha Thalassemia”, kidshealth.org, Retrieved 26-4-2018. Edited.
- Christian Nordqvist (10-1-2018), “Everything you need to know about thalassemia”, www.medicalnewstoday.co, Retrieved 26-4-2018. Edited.
- Jeffrey A Gordon (8-1-2009), “Alpha Thalassemia”, www.medicinenet.com, Retrieved 26-4-2018. Edited.
- Raffaella Origa and Paolo Moi (29-12-2016), “Alpha-Thalassemia”, www.ncbi.nlm.nih.gov, Retrieved 26-4-2018. Edited.