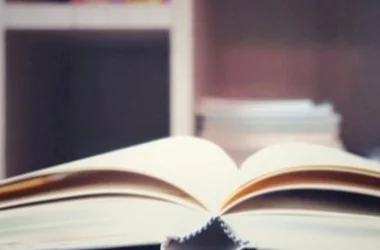مقدمة
علم الفلك هو العلم الذي يهتم بدراسة كل ما هو موجود في الكون خارج نطاق الغلاف الجوي لكوكبنا. يشمل ذلك الكواكب والنجوم والشمس والمجرات البعيدة. يعتمد هذا العلم على استخدام التلسكوبات وغيرها من الأدوات لرصد ودراسة هذه الأجرام السماوية.
الجذور التاريخية لعلم الفلك
يُعتبر علم الفلك من أوائل العلوم الطبيعية التي وصلت إلى درجة عالية من التطور والقدرة على التنبؤ. يرجع هذا النجاح المبكر إلى عدة عوامل، منها الاستقرار والبساطة النسبية التي تميز بها علم الفلك في مراحله الأولى، بالإضافة إلى طبيعته الرياضية، حيث كان يُنظر إليه في اليونان القديمة كفرع من فروع الرياضيات. كما استفاد علم الفلك من ارتباطه الوثيق بالدين والفلسفة.
تمتاز التقاليد الفلكية بالاستمرارية، حيث تم الحفاظ على بعض الملاحظات البابلية المتعلقة بكوكب الزهرة والتي تعود إلى الألفية الثانية قبل الميلاد. بحلول القرن الرابع قبل الميلاد، وصل علم الفلك البابلي إلى مستوى عالٍ من الدقة. وفي النصف الألفية اللاحقة، قدم علماء الفلك اليونانيون إسهامات كبيرة، حيث أضافوا بصمتهم الخاصة إلى ما حققه البابليون.
في بداية العصور الوسطى، أصبحت اللغة العربية هي اللغة الرائدة في مجال التعلم الفلكي، بعد أن كانت اللغة اليونانية هي المهيمنة. أتقن علماء الفلك في العالم الإسلامي ما حققه اليونانيون، وسرعان ما أضافوا إليه. ومع إحياء التعلم في أوروبا خلال عصر النهضة، أصبحت اللغة اللاتينية هي اللغة الرائدة في علم الفلك، واعتمد علماء الفلك الأوروبيون في البداية على علم الفلك اليوناني، بالإضافة إلى ترجمة الأعمال الفلكية من اللغة العربية.
دراسة حركات الأجرام السماوية
منذ فجر الحضارة وحتى وقت قريب، هيمنت دراسة حركات الأجرام السماوية على علم الفلك. كان هذا العمل ضرورياً للتنجيم، وتحديد الجداول الزمنية، والتنبؤ بالكسوف. تكتسب العلاقة بين التقويم وحركات الأجرام السماوية أهمية خاصة؛ لأنها تعني أن علم الفلك ضروري لتحديد أبسط الوظائف الأساسية للمجتمعات، بما في ذلك زراعة المحاصيل وحصادها والاحتفال بالأعياد الدينية.
كان المصريون القدماء على دراية بهذه الظواهر العامة، إلا أن دراستهم المنهجية للحركات السماوية اقتصرت على ارتباط فيضان النيل بظهور نجم الشعرى اليمانية. تم التخلي عن محاولة مبكرة لوضع تقويم يعتمد على أطوار القمر بسبب تعقيدها، ونتيجة لذلك لم تساهم الحضارة المصرية بشكل كبير في تطور علم الفلك.
هناك دلائل على وجود اهتمام أكبر بعلم الفلك فيما يتعلق بوجود المحاور الحجرية القديمة والدوائر الحجرية في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا العظمى، وأبرزها ستونهنج في إنجلترا، والتي تعود إلى حوالي 3000 قبل الميلاد. كانت هذه المجموعة من الأحجار الضخمة تعمل كمرصد قديم، حيث كان الكهنة يتابعون حركة الشمس السنوية كل صباح لتحديد بداية الفصول.
الجداول الفلكية البابلية
في الفترة ما بين 1800 إلى 400 قبل الميلاد، وضع البابليون تقويماً يعتمد على حركة الشمس وأطوار القمر. وخلال السنوات الـ 400 التالية، ركزوا اهتمامهم على التنبؤ بالوقت المحدد لظهور الهلال الجديد وتحديد بداية الشهر بناءً على هذا الحدث.
الأفلاك والمدارات عند الإغريق
اتبع اليونانيون القدماء نهجًا هندسيًا، بدلاً من النهج العددي، لفهم حركات الكواكب والنجوم والأجرام السماوية. تأثروا بمفهوم الفيلسوف أفلاطون عن كمال الحركة الدائرية، وسعوا إلى تمثيل حركة الأجرام السماوية باستخدام الأفلاك والدوائر.
كان أفلاطون أول من قدم حلاً لهذا، حيث افترض أن كل كوكب مرتبط بمجموعة من الأفلاك المتداخلة التي تدور حول الأرض. ومع ذلك، فشل هذا المخطط في تفسير التباين في سطوع الكواكب، وتم تضمين هذا المخطط في علم الكونيات لأرسطو خلال القرن الرابع الميلادي.
حاولت الحضارة الهيلينية وصف الكون المادي. تطورت الحضارة الهلنستية التي تلت فتوحات الإسكندر الأكبر على مدى القرون الأربعة التالية وسرعان ما سادت الآليات الرياضية لتفسير الظواهر السماوية، وكان أساس هذا النهج مجموعة متنوعة من الدوائر المعروفة باسم الخارج المركز والدائرة الحاملة والفلك التدويري.