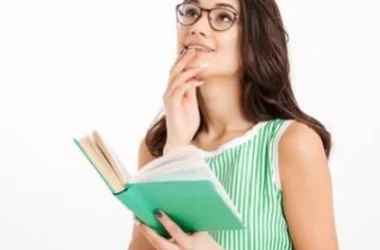تمثل الفترة بين العصرين الأموي والعباسي حقبة زمنية مهمة في تاريخ الحضارة الإسلامية، شهدت تحولات عميقة في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الجانب الديني. سنستعرض في هذا المقال ملامح التدين في هذين العصرين، مع التركيز على أهم التيارات الفكرية والمذهبية التي ظهرت، وكيف أثرت على المجتمع.
نظرة على التدين في الحقبة الأموية
سعى الأمويون جاهدين للحفاظ على جوهر العقيدة الإسلامية وحمايتها من أي تشويه أو تغيير. ومع ذلك، لم يكن تحقيق هذا الهدف سهلاً بسبب الاختلاط الواسع بين العرب والشعوب الأخرى ذات المعتقدات المختلفة، مما أثر على معتقدات بعض المسلمين.
وجدت الحركات التي سعت إلى إحداث خلل في عقائد المسلمين بيئة خصبة في الجزء الشرقي من الدولة الإسلامية، خاصة في العراق وفارس وخراسان، حيث كان التأثر بالديانات الفارسية القديمة واضحاً. كما ظهرت بعض هذه المذاهب في الشام، حيث يمكن ملاحظة تأثيرات نصرانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المذاهب لم تحظ بتأثير كبير ولم تجد قبولاً واسعاً بين المسلمين، الذين ظلوا متمسكين بعقيدتهم الإسلامية.
المدارس الفكرية في العصر الأموي
من بين أقدم المذاهب التي ظهرت في العصر الأموي ما يرتبط بالمختار بن أبي عبيد الثقفي، وذلك في الفترة التي شهدت تراجعاً في قوة الحكم الأموي بعد وفاة يزيد بن معاوية وتنازل ابنه معاوية عن الخلافة. وفي سنة 79 هـ، علم عبد الملك بن مروان بظهور رجل في الشام يدعي النبوة، وهو الحارث بن سعيد، فأمر بالقبض عليه وطلب من العلماء مناقشته.
كما ظهر في العراق معبد الجهني، الذي يعتبر من أوائل المنتمين إلى المذهب القدري، وهو مذهب يرفض فكرة القدر. تعود جذور هذه الفكرة إلى مصادر نصرانية. ثار الجهني وابن الأشعث على الحكم الأموي، وبعد فشل الثورة، ألقى الحجاج القبض عليه وقتله بعد عام 80 هـ. انتقلت هذه الأفكار القدرية إلى معبد آخر في الشام يدعى غيلان الدمشقي.
كان غيلان مولى لآل عثمان بن عفان، وقد أضاف إلى هذه الأفكار المزيد من التأصيل الجدلي. عندما سمع عمر بن عبد العزيز بذلك، استدعاه وجادله وحاوره في هذه الأفكار، وأوضح له ضلالها، فأظهر الدمشقي الاقتناع والتراجع. امتنع غيلان عن الحديث في القدرية حتى وفاة عمر، ثم عاد مرة أخرى إلى نشرها، فاستدعاه هشام بن عبد الملك بعد توليه الخلافة.
قال له هشام: “ويحك! قل ما عندك، إن كان حقًّا اتبعناه، وإن كان باطلاًَ رجعتَ عنه.” فناظره ميمون بن مهران والأوزاعي، فلما تبين خطؤه وإصراره على ضلالته، أمر هشام بقتله. ظهر في الشام أيضاً الجعد بن درهم، مولى بني الحكم، وكان معلماً لمروان بن محمد، آخر خلفاء بني أمية، وكان يؤمن بفكرة خلق القرآن.
التدين في الحقبة العباسية
على الرغم من أن المجتمع العباسي شهد ظهور الزندقة والمجون، إلا أن ذلك كان محصوراً في طبقة محدودة من الناس. كانت مساجد بغداد تعج بالعباد والنساك، وازدهر الوعظ في العصر العباسي، حيث كان ممزوجاً بالعبرة والحكمة التي تخشع لها القلوب. من أشهر نساك هذا العصر عبد الواحد بن زيد، كما ظهر التصوف ومن المتصوفين: رابعة العدوية وإبراهيم ابن أدهم البلخي وشقيق البلخي.
ازدهرت الدراسات الفقهية في العصر العباسي على أسس علمية واضحة، وكان معظم الفقهاء يعتمدون في اجتهادهم على القرآن الكريم والسنة النبوية، ولم يعتمدوا على الاستنباط الشخصي إلا في مواضع قليلة.
مع مرور الوقت، ظهرت مذاهب فقهية وتشريعية مختلفة: مذهب أبي حنيفة في الكوفة والعراق، ومذهب مالك بن أنس في المدينة والحجاز، واستمد الشافعي من المذهبين مذهباً خاصاً به، أما المذهب الرابع فهو مذهب أحمد بن حنبل، وهو المذهب الذي اتبعه أغلب أهل بغداد.
كان للشيعة أيضاً نشاط خاص بهم في الفقه، فألّف الإمام العلوي جعفر بن الصادق كتباً متعددة في الفقه، منها كتاب “مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة”. ومن الجدير بالذكر أن العلم الذي ازدهر في العصر العباسي هو علم الكلام، وهو العلم المعني بالجدل الديني في أصول العقيدة.
المراجع
- غير محدد (19/4/2010)،”الخلافة الأموية والمذاهب الضالة”،قصة الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 22/2/2022. بتصرّف.
- شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، صفحة 84-86. بتصرّف.
- شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، صفحة 129-130. بتصرّف.
- شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، صفحة 132. بتصرّف.