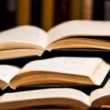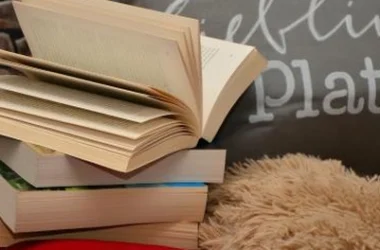جدول المحتويات
مقدمة
الشعر في العصر الجاهلي يمثل سجلاً حافلاً لحياة العرب قبل الإسلام، ويتميز بتنوع أغراضه وتعدد موضوعاته. يمكننا تلمس هذا التنوع من خلال استعراض جهود الباحثين والشعراء في تصنيف هذه الأغراض. من بين المحاولات الأولى، نجد تقسيم أبي تمام في كتابه “الحماسة”، حيث صنف الشعر إلى عشرة أقسام، شملت الحماسة، والمراثي، والأدب، والنسيب، والهجاء، والضيافة (التي تضمنت المديح)، والصفات، والسير، والنعاس، والمُلَح، وذم النساء.
لكن، لا يخفى على أحد التداخل الوثيق بين هذه الأقسام. فالضيافة، على سبيل المثال، يمكن اعتبارها جزءًا من المديح، بينما السير والنعاس يندرجان تحت الوصف. ومع مرور الوقت، ظهرت تقسيمات أخرى حاولت تبسيط هذه الأغراض وتحديدها بشكل أكثر دقة.
يُعد تقسيم أبي هلال العسكري من بين أبرز هذه المحاولات، حيث حصر الأغراض الشعرية في المديح، والهجاء، والوصف، والتشبيه، والمراثي، والاعتذار (الذي أضافه النابغة الذبياني). ومع ذلك، لم يغفل العسكري عن أهمية الحماسة والفخر، اللذين كانا من أبرز الموضوعات في ذلك العصر، كما أشار إلى أن الوصف والتشبيه غالبًا ما يتداخلان مع الأغراض الأخرى. إضافة إلى ذلك، لا يمكن إغفال الغزل والنسيب كجزء أساسي من الشعر الجاهلي.
الأهداف الأساسية للشعر
بناءً على ما سبق، يمكننا تحديد الأغراض الشعرية الرئيسية في العصر الجاهلي بالمديح، والهجاء، والرثاء، والاعتذار، والفخر، والوصف، والغزل. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأغراض غالبًا ما تتداخل فيما بينها، خاصة في الشعر الجاهلي.
وفيما يلي تفصيل لأبرز هذه الأغراض:
الفخر والاعتزاز
كانت حياة العرب في البادية تدفعهم إلى الفخر والاعتزاز بأمجادهم وأنسابهم. يرى ابن رشيق أن الفخر هو في جوهره مديح للنفس والقبيلة، وأن كل ما يحسن في المديح يحسن في الفخر، والعكس صحيح.
بالمقابل، يعتبر الرافعي أن الفخر هو تسجيل للتاريخ. فالفخر بالبطولات في المعارك يستلزم تسجيل تفاصيل تلك المعارك، والفخر بالكرم يستوجب ذكر الأحداث التي استدعت هذا الكرم.
على أي حال، لعب الفخر دورًا هامًا في الشعر العربي الجاهلي، حيث كان الشاعر يتباهى بنفسه وبقبيلته. خير مثال على ذلك معلقة عمرو بن كلثوم، التي تمحورت حول الفخر، ومنها قوله:
أَبا هِندٍ فَلا تَعَجَل عَلَينا
وَأَنظِرنا نُخَبِّركَ اليَقينا
بِأَنّا نورِدُ الراياتِ بيضًا
وَنُصدِرُهُنَّ حُمراً قَد رَوينا
وَأَيّامٍ لَنا غُرٍّ طِوالٍ
عَصَينا المَلكَ فيها أَن نَدينا
وَسَيِّدِ مَعشَرٍ قَد تَوَّجوهُ
بِتاجِ المُلكِ يَحمي المُحجَرينا
تَرَكنا الخَيلَ عاكِفَةً عَلَيهِمُ
مُقَلَّدَةً أَعِنَّتَها صُفونا
في هذه الأبيات، يفتخر الشاعر ببسالة قومه في الحروب، وكيف أنهم يعصون الملوك ولا يخضعون لهم، بل ويحاصرون الملوك حتى يقتلونهم. ويستمر في القصيدة نفسها ليقول:
إِذا ما المَلكُ سامَ الناسَ خَسفاً
أَبَينا أَن نُقِرَّ الذُلَّ فينا
مَلَأنا البَرَّ حَتّى ضاقَ عَنّا
وَنَحنُ البَحرُ نَملأُهُ سَفينا
إَذا بَلَغَ الفِطامَ لَنا وَليدٌ
تَخِرُّ لَهُ الجَبابِرُ ساجِدينا
ومن أبيات الفخر أيضًا قول امرئ القيس، الذي يعتبره بعض النقاد من أفخر الأبيات:
ما ينكر الناس منا حين نملكهم
كانوا عبيدا وكنا نحن أربابا؟
الإطراء والمديح
الكبرياء صفة فطرية في الإنسان، وقد استغلها بعض الشعراء في العصر الجاهلي للتكسب، حيث كانوا يتوجهون بالمديح للملوك والأمراء، وينالون منهم العطايا. إلا أن هناك نوعًا آخر من المديح، وهو المديح الصادق الذي يوجه لإنسان يستحقه، لا طمعًا في مكافأة، بل اعترافًا بفضله.
برز شعراء من أصحاب المعلقات في كلا النمطين من المديح. أما شاعر المديح الصادق فهو زهير بن أبي سلمى، الذي مدح في معلقته هرم بن سنان والحارث بن عوف، تقديرًا لجهودهما في إيقاف الحرب بين عبس وذبيان، وفي معلقته يقول:
فَأَقسَمتُ بِالبَيتِ الَّذي طافَ حَولَهُ
رِجالٌ بَنَوهُ مِن قُرَيشٍ وَجُرهُمِ
يميناً لَنِعمَ السَيِّدانِ وُجِدتُما
عَلى كُلِّ حالٍ مِن سَحيلٍ وَمُبرَمِ
تَدارَكتُما عَبساً وَذُبيانَ بَعدَما
تَفانوا وَدَقّوا بَينَهُم عِطرَ مَنشِمِ
وَقَد قُلتُما إِن نُدرِكِ السِلمَ واسِعاً
بِمالٍ وَمَعروفٍ مِنَ الأَمرِ نَسلَمِ
فَأَصبَحتُما مِنها عَلى خَيرِ مَوطِنٍ
بَعيدَينِ فيها مِن عُقوقٍ وَمَأثَمِ
عَظيمَينِ في عُليا مَعَدٍّ وَغَيرِها
وَمَن يَستَبِح كَنزاً مِنَ المَجدِ يَعظُمِ
فَأَصبَحَ يَجري فيهُمُ مِن تِلادِكُم
مَغانِمُ شَتّى مِن إِفالِ المُزَنَّمِ
تُعَفّى الكُلومُ بِالمِئينَ فَأَصبَحَتي
يُنَجِّمُها مَن لَيسَ فيها بِمُجرِمِ
يُنَجِّمُها قَومٌ لِقَومٍ غَرامَةً
وَلَم يُهَريقوا بَينَهُم مِلءَ مِحجَمِ
أما فيما يتعلق بمديح التكسب، فقد اشتهر فيه اثنان من أصحاب المعلقات، وهما النابغة الذبياني والأعشى. ومن مديح الأعشى:
فَإِذا تُجَوُّزُها حِبالَ قَبيلَةٍ
أَخَذَت مِنَ الأُخرى إِلَيكَ حِبالَها
قِبَلَ اِمرِئٍ طَلقِ اليَدَينِ مُبارَكٍ
أَلفى أَباهُ بِنَجوَةٍ فَسَما لَها
فَكَأَنَّها لَم تَلقَ سِتَّةَ أَشهُرٍ
ضُرّاً إِذا وَضَعَت إِلَيكَ جِلالَها
وَلَقَد نَزَلتُ بِخَيرِ مَن وَطِئَ الحَصى
قَيسٍ فَأَثبَتَ نَعلَها وَقِبالَها
ما النيلُ أَصبَحَ زاخِراً مِن مَدِّهِ
جادَت لَهُ ريحُ الصَبا فَجَرى لَها
زَبِداً بِبابِلَ فَهوَ يَسقي أَهلَها
رَغَداً تُفَجِّرُهُ النَبيطُ خِلالَها
غالبًا ما كان النابغة يمدح النعمان بن المنذر، ومن مديحه فيه:
الواهِبُ المِئَةَ المَعكاءَ زَيَّنَها
سَعدانُ توضِحَ في أَوبارِها اللِبَدِ
وَالأُدمَ قَد خُيِّسَت فُتلاً مَرافِقُها
مَشدودَةً بِرِحالِ الحيرَةِ الجُدُدِ
وَالراكِضاتِ ذُيولَ الرَيطِ فانَقَها
بَردُ الهَواجِرِ كَالغِزلانِ بِالجَرَدِ
الذم والهجاء
كان للهجاء حضور قوي في الشعر الجاهلي، لدرجة أن العربي الجاهلي كان يخشى الهجاء أشد الخوف. يُروى أن من أراد سلب شيء من قبيلة أخرى لم يجرؤ على سلب شعرائهم خشية هجائهم، وإذا فعل ذلك، كان يعيد المسلوب أو يدفع ثمنه. استخدم بعض الشعراء الهجاء للانتقاص من قيمة القبائل الأخرى.
من بين شعراء المعلقات الذين استخدموا الهجاء زهير والنابغة والأعشى وطرفة. ومن هجاء الأعشى قوله:
لَقَد سَفَرَت بَنو عَبدانَ بَيناً
فَما شَكَروا بِلَأمي وَالقِداحِ
إِلَيكُم قَبلَ تَجهيزِ القَوافي
تَزورُ المُنجِدينَ مَعَ الرِياحِ
فَما شَتمي بِسَنّوتٍ بِزُبدٍ
وَلا عَسَلٍ تُصَفِّقُهُ بِراحِ
وَلَكِن ماءُ عَلقَمَةٍ وَسَلعٍ
يُخاضُ عَلَيهِ مِن عَلَقِ الذُباحِ
لَأُمُّكَ بِالهِجاءِ أَحَقُّ مِنّاً
لِما أَبَلَتكَ مِن شَوطِ الفِضاحِ
الاسترضاء والاعتذار
كما ذكرنا سابقًا، يُعد الاعتذار أحد أغراض الشعر الجاهلي، ويُعتبر النابغة الذبياني أول من سلك هذا الطريق. فقد اعتذر للنعمان بن المنذر، الذي كان قد أبعده وهدر دمه بعد أن وصله أن النابغة تغزل بزوجته. فأرسل إليه النابغة معلقته التي يقول فيها:
فَتِلكَ تُبلِغُني النُعمانَ إِنَّ لَهُ
فَضلاً عَلى الناسِ في الأَدنى وَفي البَعَدِ
وَلا أَرى فاعِلاً في الناسِ يُشبِهُهُ
وَلا أُحاشي مِنَ الأَقوامِ مِن أَحَدِ
إِلّا سُلَيمانُ إِذ قالَ الإِلَهُ لَهُ
قُم في البَرِيَّةِ فَاِحدُدها عَنِ الفَنَدِ
وَشَيِّسِ الجِنَّ إِنّي قَد أَذِنتُ لَهُم
يَبنونَ تَدمُرَ بِالصُفّاحِ وَالعَمَدِ
فَمَن أَطاعَكَ فَاِنفَعهُ بِطاعَتِهِ
كَما أَطاعَُكَ وَادلُـلْه عَلى الرَشَدِ
وَمَن عَصاكَ فَعاقِبهُ مُعاقَبَةً
تَنهى الظَلومَ وَلا تَقعُد عَلى ضَمَدِ
إِلّا لِمِثلِكَ أَو مَن أَنتَ سابِقُهُ
سَبقَ الجَوادَ إِذا اِستَولى عَلى الأَمَدِ
أَعطى لِفارِهَةٍ حُلوٍ تَوابِعُها
مِنَ المَواهِبِ لا تُعطى عَلى نَكَدِ
الواهِبُ المِئَةَ المَعكاءَ زَيَّنَها
سَعدانُ توضِحَ في أَوبارِها اللِبَدِ
وَالأُدمَ قَد خُيِّسَت فُتلاً مَرافِقُها
مَشدودَةً بِرِحالِ الحيرَةِ الجُدُدِ
وَالراكِضاتِ ذُيولَ الرَيطِ فانَقَها
بَردُ الهَواجِرِ كَالغِزلانِ بِالجَرَدِ
وَالخَيلَ تَمزَعُ غَرباً في أَعِنَّتِها
كَالطَيرِ تَنجو مِنَ الشُؤبوبِ ذي البَرَدِ
اِحكُم كَحُكمِ فَتاةِ الحَيِّ إِذ نَظَرَت
إِلى حَمامِ شِراعٍ وارِدِ الثَمَدِ
المراجع
- شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي لشوقي ضيف، صفحة 195-196. بتصرّف.
- ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، صفحة 143. بتصرّف.
- مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، صفحة 69. بتصرّف.
- عمرو بن كلثوم، “ألا هبي بصحنك فاصبحين”، الديوان.
- ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، صفحة 144. بتصرّف.
- مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، صفحة 64. بتصرّف.
- الزوزني، شرح المعلقات السبع للزوزني، صفحة 126. بتصرّف.
- زهير بن لأبي سلمى، “أمن أم أوفى دمنة لم تكلم”، الديوان.
- الأعشى، “رحلت سمية غدوة أجمالها”، الديوان.
- النابغة الذبياني، “يا دار مية بالعلياء فالسند”، الديوان.
- شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي لشوقي ضيف، صفحة 197-198. بتصرّف.
- مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، صفحة 61. بتصرّف.
- الأعشى، “أتاني ما يقول”، الديوان.