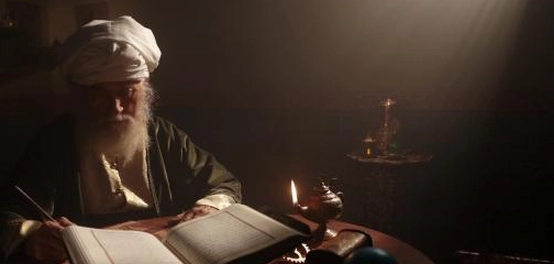مفهوم علم أصول الفقه
علم أصول الفقه يُعدّ من أهم العلوم الشرعية، فهو يبحث في الأدلة الشرعية وكيفية استنباط الأحكام منها. لفهم هذا العلم، يجب أولاً استعراض معاني المصطلحات الأساسية المكونة له.
في البداية، يجب توضيح مفهومي الأصل والفقه قبل الخوض في تعريف أصول الفقه.
معنى الأصل
الأصل في اللغة يعني الأساس، أو ما يُبنى عليه الشيء. أما في الاصطلاح، فيعني الدليل الذي يُستند إليه في استنباط الأحكام.
معنى الفقه
الفقه لغةً يعني الفهم مطلقاً. وقد ذهب إلى هذا المعنى العديد من العلماء.
تعريف علم أصول الفقه
تنوعت تعريفات العلماء لعلم أصول الفقه، ولكن يمكن القول بأن التعريف الأقرب للصحة هو: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هو العلم الذي يبحث في الأدلة الشرعية الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، مع بيان صفات المجتهد وشروطه.
تطور علم أصول الفقه عبر التاريخ
إن فهم تاريخ هذا العلم يساعد على استيعاب مسائله وقواعده بشكل أفضل. لقد مر علم أصول الفقه بمراحل تطورية هامة ساهمت في شكله الحالي.
اجتهاد الصحابة في حضرة النبي وفي غيابه
لقد أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه بالاجتهاد، وكانوا يجتهدون في حضرته وغيبته. عندما كانوا يبتعدون عن المدينة ويتعذر عليهم الرجوع إليه، كانوا يفتون بكتاب الله، الذي عرفوا أسباب نزول آياته ودلالات ألفاظه. فإن لم يجدوا فيه ما يطلبون، لجأوا إلى السنة الصحيحة التي حفظوها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وإذا لم يجدوا في السنة حكماً لما عرض لهم، اجتهدوا بآرائهم، فإذا عادوا إلى المدينة عرضوا الأمر عليه -صلى الله عليه وسلم-؛ فيرشدهم إلى الصواب أو الخطأ، وكان -صلى الله عليه وسلم- يفرح باجتهادهم في هذه الظروف.
وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على ذلك، فعندما أرسل النبي معاذ بن جبل -رضي الله عنه- إلى اليمن قاضياً، سأله كيف سيقضي إذا عرض له قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدره وقال: “الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله”.
تأييد النبي لاجتهادات الصحابة
كان الصحابة -رضي الله عنهم- يجتهدون في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكثير من الأحكام، محاولين الوصول إلى فتاوى قاطعة. وعندما أمرهم النبي بالصلاة في بني قريظة، اجتهد البعض وصلوا في الطريق.
وعندما كان علي -رضي الله عنه- في اليمن، أتاه ثلاثة رجال يتخاصمون في غلام، كل منهم يدعي أنه ابنه. فأقرعه بينهم، وجعل الولد للقارع، وأعطى الرجلين ثلثي الدية. فلما بلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: “بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله أتبعثني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء قال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد”.
العوامل المساعدة على الاجتهاد في عصر الصحابة
يتضح لنا أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا في عصر النبوة يقضون ويفتون بكتاب الله وسنة رسوله، ويستنبطون فيما لا نص فيه بقدرتهم التشريعية، التي ترسخت في نفوسهم من صحبتهم له -عليه الصلاة والسلام-.
كانوا ملمين بأسباب نزول الآيات وورود الأحاديث، وفهم مقاصد الشارع، ومبادئ التشريع، وفوق هذا طبعوا على حدة الذهن، وصفاء الخاطر، وسمو الفهم، لذلك لم يكونوا بحاجة إلى وضع أصول وقواعد في علم العربية أو غيرها ليسيروا عليها في اجتهادهم؛ لأن ذلك كان فيهم فطرة وطبيعة.
وبعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وانقطاع الوحي، وجد الصحابة أنفسهم أمام حوادث كثيرة تتزايد يوماً بعد يوم كلما اتسعت رقعة الإسلام، ولم تكن هذه الحوادث تندرج تحت نصوص الكتاب والسنة، مما دفعهم إلى الاجتهاد، وإلحاق الأشباه بالأشباه، والأمثال بالأمثال.
منهج الصحابة في استنباط الأحكام
كانت الحياة في عهد الرسول تسير وفق الأحكام التي كان يتلقاها من الوحي، سواء من خلال القرآن أو السنة. وكان الرسول يوضح جميع الأمور الفقهية للصحابة بأفعاله وأقواله، وكان الصحابة يتسابقون في النقل عن رسول الله، وحفظ الأحاديث والمسائل الفقهية.
وقد أجمع الصحابة على وجوب العمل بما يؤخذ عن الرسول، سواء في الفعل أو القول، والأخذ بالأمور التي يثقون بأنها منقولة بشكل صحيح عن الرسول، ولا يتم الأخذ إلا بالأمور التي يجمع عليها جميع الصحابة، أما تلك التي يحدث فيها بعض الإنكار فلا يتم الأخذ بها.
يجب التأكيد على أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا منضبطين في اجتهادهم بقواعد علم الأصول ومناهجه؛ فلا اجتهاد بغير منهج، ولا استنباط من غير قاعدة، غير أنهم لم يكونوا بحاجة إلى تدوين هذه القواعد للأسباب التي سبق ذكرها.
قواعد وأسس في فقه الصحابة
ظهرت بعض هذه القواعد والأسس في فقه الصحابة والتابعين عند استدلالهم على آرائهم، ومناقشة آراء المخالفين لهم، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في الحوادث والوقائع الآتية:
تقديم المصلحة العامة عند التعارض
عندما اختلف الصحابة في توزيع الأراضي التي غنمها الفاتحون في العراق، ناقش عمر بن الخطاب معارضيه، ثم تمسك بضرورة الدفاع عن البلاد، وحاجة ذلك إلى موارد ثابتة، وأن هذه المصلحة العامة يجب تقديمها على المصلحة الخاصة للجنود المقاتلين، وموقف عمر هذا يستند إلى قاعدة أصولية راعاها التشريع في أحكامه، وهي تقديم المصلحة العامة عند التعارض.
وتطبيقاً لهذا الأصل، وإعمالاً لتلك القاعدة الأصولية، منع الصحابة أبا بكر -رضي الله عنه- حين تولى الخلافة من التجارة، على أن تكون كفايته في بيت مال المسلمين؛ لأن النظر في مصالح المسلمين من المصالح العامة، فيجب تقديمها على مصلحته الخاصة في اتخاذ الحرفة التي يريدها، والتجارة التي يرضاها.
سد الذرائع
حينما تكلم الصحابة في حد شارب الخمر، استدل علي -رضي الله عنه- على حد شارب الخمر بثمانين جلدة، وهي واقعة لا نص فيها: (إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فيكون عليه حد المفتري) أي القاذف.
وهو بهذا يقرر قاعدة من قواعد الاجتهاد، تصرف الشارع على وفقها، وراعاها في تشريع الأحكام، وهي قاعدة (إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء، وإعطاء المظنة حكم المظنون)، وهي القاعدة التي أطلق عليها الأصوليون فيما بعد (سد الذرائع).
النص المتأخر ينسخ النص المتقدم أو يخصصه
واستدل ابن مسعود على أن عدة المتوفى عنها زوجها تكون بوضع الحمل؛ لقوله -تعالى-: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) سورة الطلاق، آية:4.
ولما عورض بقوله -تعالى- في سورة البقرة: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) سورة البقرة، آية:234، قرر قاعدة أصولية راعاها في اجتهاده.
وقال: “أشهد أن سورة النساء القصرى -يعني سورة الطلاق- نزلت بعد سورة النساء الطولي -يعني سورة البقرة-“، ومعنى هذا القول أن النص المتأخر ينسخ النص المتقدم أو يخصصه.
وهكذا نجد أن الصحابة -رضوان الله عليهم- قد تقيدوا في اجتهادهم بقواعد أصولية، وإن لم تكن بهم حاجة إلى تدوينها في ذلك الوقت.
الإمام الشافعي و تدوين علم أصول الفقه
قبل كتابة الشافعي لرسالته، كان الخلاف قد اشتد بين أهل السنة وأهل الرأي، الذي يضم القياس والاستحسان، وكان لا بد من وجود قواعد مدونة تكون مرجعاً لفض النزاع، ولم يكن تحصيل هذه القواعد والقوانين بالأمر السهل، وليس بإمكان أي عالم أن يقوم بهذه المهمة؛ ذلك أن وضع نظام موحد أو شبه موحد لطريقة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها أمر في غاية الخطورة والأهمية.
كما أن هذه المهمة تقتضي اطلاعاً واسعاً على مقاصد الشارع، وقدرة على إدراكها ومعرفتها من خلال كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وإلماماً شاملاً بمذاهب العلماء، ومدارك فقههم من عهد الصحابة حتى وقته، ومعرفة تامة بلغة العرب.
وذلك لا يتيسر إلا لقليل نادر ممن يهبهم الله القدرة على كل هذا؛ ليعز بهم دينه وشريعته؛ فقيض الله بهذه المهمة عالم قريش الإمام الشافعي -رضي الله عنه-، وكان حقيقاَ بها وأهلاً لها، فشرع -رحمه الله- في كتابه الذي يعرف بالرسالة، حيث حرر فيها المباحث، وحقق الدقائق، وحل المشاكل، ورتب المسائل.
وأكد جميع العلماء على أن الشافعي -رحمه الله- بقيامه بإنجاز هذا المؤلف يكون أول من جمع قواعد علم الأصول ودونها، واستدل على اعتبارها، ثم استنبط منها ما لم يكن الفقهاء السابقون قد استنبطوه منها.