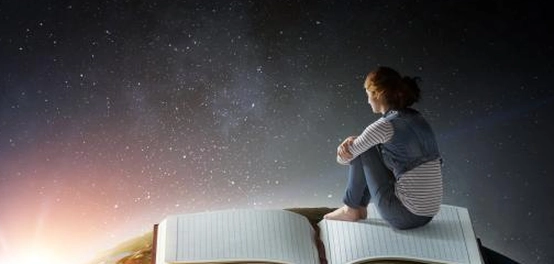فهرس المحتويات
ماهيةُ الاستعارةِ المكنيةِ
تُعدّ الاستعارةُ المكنيةُ من فنونِ البلاغةِ العربيةِ، وهي جزءٌ لا يتجزّأ من علمِ البيانِ، الذي يُعنى بتزيينِ الكلامِ وتوضيحه. وتُعرّفُ الاستعارةُ في اللغةِ بأنّها السترُ والخفاءُ، أمّا اصطلاحًا، فهي انتقالٌ في المعنى من مُشبَّه إلى مُشبَّه به، مع حذفِ المُشبَّه به والاكتفاءِ بإحدى لوازمه، مُشيرًا بذلك إلى المعنى المقصود.
يُوضحُ السكاكيُّ تعريفها بقوله: “أن يُذكر المشبه، ويُراد به المشبه به، دالًا على ذلك بقرينة أي دليل يُشير إلى المحذوف”. وهذا يُبرزُ الدقةَ في نقلِ المعنى المُراد، مع الاعتمادِ على دلالاتٍ ضمنيةٍ تُفهمُ من سياق الكلام.
أركانُ بناءِ الاستعارةِ المكنيةِ
تُشبهُ الاستعارةُ المكنيةُ التشبيهَ في بعضِ جوانبها، لكنّها تختلفُ عنه في حذفِ أحدِ أركانهِ الأساسية. ففي التشبيه، لا بُدَّ من وجودِ المُشبَّه والمُشبَّه به، أمّا في الاستعارةِ المكنيةِ، فيُحذفُ المُشبَّه به، ويُستبدلُ به أحدُ لوازمه التي تُشيرُ إليه وتُبيّنُه.
وبناءً على ذلك، تتكوّنُ الاستعارةُ المكنيةُ من ثلاثةِ أركانٍ رئيسيةٍ: المُشبَّه المذكور، والمُشبَّه به المحذوف، والقرينة التي تُشيرُ إلى المُشبَّه به.
تطبيقاتٌ عمليةٌ على الاستعارةِ المكنيةِ
إليكم بعض الأمثلة لتوضيح كيفية استخدام الاستعارة المكنية:
| المثال | التوضيح |
|---|---|
| قال تعالى:”رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا”.[٤] | هنا، شُبِّه الرأس بالوقود، وحُذف المشبه به، ورمز إليه بـ”اشتعل”، وهي قرينة تدل على حرارة الوقود. |
| قال الحجّاج:”وإنّي لأرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها، وإنّي لصاحبها”. | شَبَّهَ الحجاج الرؤوس بالثمار، وحذف المشبه به، مُستخدِمًا “أينعت” و”قطافها” كقرينةٍ تُشيرُ إلى الثمار. |
| قال أعرابي في المدح:”فلان يرمي بطرفه حيث أشار الكرم”. | شُبِّهَ الكرمُ بإنسانٍ، وحُذفَ المُشبَّه به، واستُخدِمَ “أشار” كقرينةٍ تُشيرُ إلى فعل الإنسان. |
| قال ابن سنان الخفاجي في وصف حمامة: وهاتفة في البان تملي غرامها علينا وتتلو من صبابتها صحفًا | هنا، شُبِّهَت الحمامة بامرأة، وحُذفَ المُشبَّه به، واستُخدِمَ “تملي” و”تتلو” كقرينةٍ تُشيرُ إلى فعل المرأة. |
| قال شاعر يخاطب طائراً:أنت في خضراء ضاحكة من بكاء العارض الهتن | شُبِّهَت الأرضُ الخضراءُ بالآدمي، وحُذفَ المُشبَّه به، واستُخدِمَ “ضاحكة” كقرينةٍ تُشيرُ إلى ابتسامة الإنسان. |
| قال الشاعر: عضنا الدهر بنابه ليت ما حل بنا به | شُبِّهَ الدهرُ بحيوانٍ مفترس، وحُذفَ المُشبَّه به، واستُخدِمَ “عض” كقرينةٍ تُشيرُ إلى فعل الحيوان المفترس. |
المراجع
[٤] سورة مريم، آية:٤المصادر الأخرى مُقتبسة من مراجع متخصصة في علم البلاغة العربية.