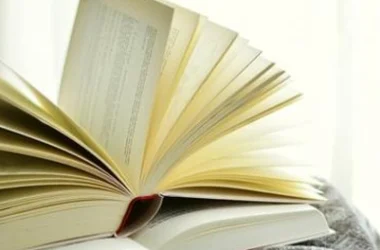من هو أبو الطيب المتنبي؟
أبو الطيب المتنبي هو شاعر عربي مشهور ذاع صيته في العصر العباسي. كان يُعرف بشخصيته الغامضة وأسلوبه الشعري الفريد. لقد أثارت كتابات المتنبي العديد من التساؤلات حول مقاصده وطريقة تفكيره، مما جعل ابن رشيق يلقبه بـ “مُلء الدنيا وشاغل الناس”.
حظي شعر المتنبي باهتمام كبير من طرف علماء اللغة والأدب، مثل ابن جنّي وأبي علي الفارسي. لقد ترك المتنبي وراءه تراثاً شعرياً غنياً يتضمن أكثر من ثلاثمائة قصيدة، تُعدّ هذه القصائد سجلّاً تاريخياً لأحداث عصره، كما تُعتبر بمثابة سيرة ذاتية للشاعر، تتيح للقارئ فهم تطور حكمتها من خلالها.
سبب تسميته بالمتنبي
تختلف الروايات حول أصل تسمية الشاعر بالمتنبي. بعض الروايات تقول إنّه كان يدّعي النبوّة في صباه، لكنّ هذه الرواية غير مؤكدة.
يُرجّح البعض الآخر أنّه سمي بالمتنبي لورعه في خُلقه، حيث كان مكثراً من ذكر الأنبياء في شعره، مُشبِّها نفسه بهم. وقد قال عن نفسه:
مَا مُقامي بأرْضِ نَخْلَةَ إلاّكمُقامِ المَسيحِ بَينَ اليَهُودِ
أنَا في أُمّةٍ تَدارَكَهَا اللّـه
غَريبٌ كصَالِحٍ في ثَمودِ
وأخيراً، يرى البعض أنّ اللقب يشير إلى “مكانٍ مرتفع” وهذا دلالةً على علوّ شِعره ورفعة مضمونه، وليس إشارةً إلى ادّعائه النبوّة.
مراحل حياة المتنبي
ميلاد المتنبي ونسبه
وُلد المتنبي في الكوفة سنة 303 هجريّة في منطقةٍ تُسمى كِندة. لا يوجد اتفاق حول نسبه، فبعض المؤرخين يُنسبه إلى قبيلة كندة، بينما يُنسبه آخرون إلى حيّ كِندة في الكوفة. كما اختلف المؤرخون في اسم والده، فمنهم من قال أنّ اسمه أحمد بن الحسين بن مرّة بن عبد الجبار الجعفي، ومنهم من قال أن اسمه أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي.
لم يذكر المتنبي والده في شعره، مما يُثير تساؤلات حول معرفته به. أمّا أمّه، فلا يُعرف عنها اسمها ولا أصلها، لكنّ بعض الرواة ذكروا أنّها كانت من الكوفة وأنها تُنسب إلى بني همدان.
أشار المتنبي إلى كرم نسب أمه في بيت رثاها فيه فقال:
لَوْ لمْ تَكُوني بِنْتَ أكْرَمِ والِدٍ
لَكانَ أباكِ الضّخْمَ كونُكِ لي أُمّ
تعليم أبو الطيب المتنبي
التحق المتنبي بكُتَّابٍ كان فيه أبناء أشراف العلويين لتلقّي علوم اللغة العربية من شعر، ونحو، وبلاغة. كما أمضى ساعات طويلة في قراءة كتب الورّاقين، مما ساهم في توسيع معارفه.
اشتهر المتنبي بحبه للعلم والأدب وذكائه الفائق وقوة حفظه. تُروى قصة طريفة عن قوة حفظه في صباه، حيث قال أحد الوراقين:
أخذ الكتاب من الرجل وصار يقلّب صفحاته ويطيل النظر فيها، فقال له الرجل: يا هذا لقد عطلتني عن بيعه، فإن كنت تبغي حفظه في هذه الفترة القصيرة فهذا بعيدٌ عليك، فقال المتنبي: فإن كنت حفظته فما لي عليك؟ قال الرجل: أعطكيه، فقال الوراق: فامسكت الكتاب أراجع صفحاته والغلام يتلو ما به حتى انتهى إلى آخره، ثم استلبه فجعله في كُمِّه ومضى لشأنه.
عاش المتنبي في البادية لمدة سنتين، مما ساعد على إتقانه للغة العربية والفصاحة، كما سافر إلى مختلف المدن والبلدان وتواصل مع علماء اللغة والأدب، وتعلم على أيديهم.
رحلات أبو الطيب المتنبي
رحلة المتنبي إلى بغداد
انتقل المتنبي إلى بغداد سنة 319 هجرية، إلّا أنّه لم يحدد تاريخ رحيله بدقة.
رحلة المتنبي إلى بلاد الشام
سافر المتنبي إلى بلاد الشام سنة 321 هجرية، وكان عمره وقتها 18 عاماً. سكن في الشام ونظم شعر المديح، حيث كانت المنطقة تعاني من حروب متعددة بسبب الصراع على السلطة.
حارب المتنبي في تلك المعارك، ومدح بعض الرجال الذين ساهموا في الصراع، مثل مساور بن محمد الرومي.
كان المتنبي قد سُجن في الشام في أيام شبابه -كما سبق الذكر- في روايات عن أسباب تسميته بالمتنبي، وقد أجمع الرُّواة على ذلك، كما أنّ المتنبي نفسّه أخبر عن ذلك في شعره.
بعد ذلك، زار المتنبي العديد من المدن في بلاد الشام، ومدح أمراءها. كان يشجعهم في مدائحه على التصدي لأعداء العرب، لا سيّما الروم الذين كانوا يُهاجمون الجيوش العربية.
أقام المتنبي عند بدر بن عمار في طبريّا لعدة سنوات، ثمّ اتّصل بأبي العشائر الحمدانيّ، والي أنطاكية. بعدها، التقى سيف الدولة الحمداني، الذي رأى فيه المتنبي صفات القائد العربي المثالي، فنشأت بينهما علاقة ود ومحبة قوية.
عاش المتنبي في كنف سيف الدولة أزهى أيام حياته، ونظم في سيف الدولة أكثر من ثمانين قصيدة، تُعتبر من روائع الشعر العربي.
أقام المتنبي عند سيف الدولة تسع سنوات، انقطع فيها لمدحه. كان أول ما قاله في مدحه في شهر جمادى الأولى سنة 373 هـ، حيث مدحه بقصيدةٍ ميميةٍ مطلعها:
وَفاؤكُما كالرَّبْع أشْجاهُ طاسمه
بأنْ تُسعِدا والدّمْعُ أشفاهُ ساجِمُهْ
كانت آخر مرةٍ أنشده مادحاً في سنة 345هـ، في قصيدةٍ ميميةٍ مطلعها:
عُقْبَى اليَمينِ على عُقبَى الوَغَى ندمُ
ماذا يزيدُكَ في إقدامِكَ القَسَمُ
كما أنشده أيضاً في نفس العام مودّعاً إيّاه في قصيدةٍ استهلّها قائلاً:
أيَا رَامِياً يُصْمي فُؤادَ مَرَامِهِ
تُرَبّي عِداهُ رِيشَهَا لسِهامِهِ
تنوع شعر المتنبي خلال هذه الفترة مع تنوع أحداث حياة سيف الدولة، فكان شعره يدور في فلَكه رغم تنوّع فنونه.
لم يدُم للمتنبي نعيم الود بينه وبين سيف الدولة، فقد أوغر الحُسّاد والوشاة صدر الأمير على الشاعر. دافع المتنبي عن نفسه بالهجوم، تارةً كقوله في لاميته:
أفي كلّ يوْمٍ تحتَ ضِبْني شُوَيْعِرٌ
ضَعيفٌ يُقاويني قَصِيرٌ يُطاوِلُ
لِساني بنُطْقي صامِتٌ عنهُ عادِلٌ
وَقَلبي بصَمتي ضاحِكٌ منهُ هازِلُ
وبالاستعطاف تارةً أخرى كقوله في داليته الشهيرة:
أزِلْ حَسَدَ الحُسّادِ عَنّي بكَبتِهمْ
فأنتَ الذي صَيّرْتَهُمْ ليَ حُسّدَا
إذا شَدّ زَنْدي حُسنُ رَأيكَ فيهِمُ
ضرَبْتُ بسَيفٍ يَقطَعُ الهَام مُغمَدَا
وبالافتخار بنفسه مرات عدة كقوله:
وَمَا الدّهْرُ إلاّ مِنْ رُواةِ قَصائِدي
إذا قُلتُ شِعراً أصْبَحَ الدّهرُ مُنشِدَ
فَسَارَ بهِ مَنْ لا يَسيرُ مُشَمِّراً
وَغَنّى بهِ مَنْ لا يُغَنّي مُغَرِّدَا
أجِزْني إذا أُنْشِدْتَ شِعراً فإنّني
بِشِعري أتَاكَ المادِحونَ مُرَدَّدَا
ودَعْ كلّ صَوْتٍ غَيرَ صَوْتي فإنّني
أنَا الطّائِرُ المَحْكِيُّ وَالآخَرُ الصّدَى
كان افتخاره بنفسه وازدراؤه لخصومه يُزيدهم بغضاً به وحسداً له، فيزيدون كيّداً ووشايةً للإيقاع بينه وبين الأمير. نجحوا في ذلك مرّةً فغضب منه سيف الدولة وجافاه، فأنشد المتنبي قصيدة يعاتبه بها وكان مطلعها:
وَاحَرّ قَلْباهُ ممّنْ قَلْبُهُ شَبِمُ
وَمَنْ بجِسْمي وَقلبي عِندَهُ سَقَمُ
ثمّ ندم واعتذر منه بقصيدة أخرى قال في مقدمتها:
ألا ما لسَيفِ الدّوْلَةِ اليَوْمَ عَاتِبَ
فَداهُ الوَرَى أمضَى السّيُوفِ مَضَارِبَا
إلى قوله:
وَإنْ كانَ ذَنْبي كلَّ ذَنْبٍ فإنّهُمَ
حا الذّنْبَ كلَّ المَحوِ مَن جاءَ تائِبَ
عفُا عنه الأمير، وهدأت الأحوال بينه وبين خصومه لفترة قصيرة. لكنّ الكَدَر عاد من جديد، لا سيما بعد أن تعرّض المتنبي للإهانة في مجلس سيف الدولة من طرف ابن خالوّيه. خرج المتنبي من مجلس الأمير غاضباً، وضاق به المقام في حلب، فعزم على الرحيل إلى مصر.
رحلة المتنبي إلى مصر
غادر أبو الطيب حلب سنة 346 هـ متوجهاً إلى مصر، حيث استدعاه كافور الإخشيدي. أقام المتنبي في مصر لمدة خمس سنوات، مدح خلالها كافور بعدة قصائد، لكنّه لم يكن يُكنّ له المحبة، بل كان يطمح لتحقيق أمانيه من خلاله.
كان كافور على درايةٍ بذلك، ولم يُحقّق للمتنبي أمانيه، بل ضيّق عليه. شعر المتنبي بالضيق والكراهية في مصر، وعاد وهجاه بعد أن مدحه.
وقد سميت قصائده في مدح كافور وهجائه في تلك الفترة بالكافوريّات.
كانت محنة المتنبي ومعاناته أثناء وجوده في مصر لها تأثير كبير على شعره. اتّسم شعره في تلك السنوات بمهارات عديدةٍ، وضع فيها خلاصة تجارب حياته كلّها.
رحلة المتنبي إلى العراق
توجه المتنبي إلى العراق بعد خيبة أمله عند كافور، حيث كان يتنقل بين الكوفة وبغداد، ثمّ توجه إلى أرجان لزيارة ابن العميد وزير عضد الدولة. مكث عنده لفترةٍ من الزمن، ومدحه بمجموعةٍ من القصائد سميت بالعميديات.
أرسل عضد الدولة بن بوّيه يدعوه للقدوم إليه، فلبى المتنبي الدعوة. وجد عند السلطان الحفاوة والتكريم، وعادت للشاعر حريّته وطموحاته. مكث في ضيافة عضد الدولة ثلاثة أشهرٍ، مدحه خلالها في ست قصائد رائعة سميت بالعضديات. لكنّ المتنبي رغب بالرحيل والعودة إلى العراق، ودّع ابن بويه بالقصيدة التي استهلها قائلاً:
فِدًى لكَ مَن يُقَصّرُ عَن مَداك
فَلا مَلِكٌ إذَنْ إلاّ فَدَاكَا
وفاة أبو الطيب المتنبي
توفي المتنبي وهو في قمة عطائه، فقد مات في الخمسين من عمره مقتولاً على يد شخصٍ يسمى فاتك الأسدي، وهو خال ضبّة الأسدي الذي هجاه المتنبّي في إحدى قصائده.
حدث ذلك في طريق عودته من شيراز إلى بغداد. اعترض فاتك طريقه ومعه جماعةً من أصحابه في منطقةٍ واقعة غرب بغداد تُسمى النعمانية، فيما لم يكن مع المتنبي عدداً مكافئاً لرجال فاتك. تقاتل الجمعان، فقُتل مُحسد ابن المتنبي، وهُمّ المتنبي بالهروب، إلّا أن غلامه استوقفه قائلاً: ألست القائل الخيلُ والليلُ والبيداءُ تَعرفني؟ فردّ عليه المتنبي قائلاً: قتلتني قتلك الله، ورجع وقاتل حتى قُتل.
تُذكر روايات متعددة حول مقتل المتنبي والأسباب التي أدّت إلى مقتله.
مميزات شعر المتنبي
اتّصف أبو الطيب المتنبي بكبريائه وشجاعته وطموحه. كما كان يُفتخر بعروبته في أبياته الشعرية. تُعتبر أفضل أشعاره تلك التي تحدّثت عن الحكمة، وفلسفة الحياة، ووصف المعارك. تميّزت هذه القصائد بالصياغة القوية والمحكمة.
يُعتبر المتنبي مفخرة للأدب العربي؛ فهو شاعر غزير الإنتاج الشعريّ، وصاحب الأمثال السائرة والحكم البليغة والمعاني المبتكرة.
لقد ساعده التنقّل بين الأمراء والملوك على تطوير موهبته الشعرية، حيث مدحهم في معظم أشعاره.
لم يحظَ شاعرٌ من شعراء العربيّة بمثل ما حظي به أبو الطيّب المتنبّي من مكانةٍ عالية. لقد كان أعجوبةً أعجزت الشعراء من بعده. بقي شعره إلى الآن يُقرأ كمصدر وحي للكثير من الأدباء والشُّعراء.
أبدع المتنبّي في صياغة أبياته صياغةً تأسرُ الألباب وتشغل القلوب. كان شاعراً ينتمي لشعراءِ المعاني، حيثُ كان موفِّقاً بين الشعر والحكمة. أخرجَ الشّعر عن قيوده وحدوده وابتكرَ الطريقة الإبداعيّة فيه.
يُمثّل شعرُ المتنبّي صورةً حقيقةً وصادقةً عن حياته وأحداثها من اضطرابات وثوراتٍ، كما عرضَ ما كان في عصره من آراءٍ ومذاهب.
تُمثّل حياةُ المتنبي المُضطّربة في شعره، فهو عبّر عن عقله وشجاعته، وطموحه وعلمه، ورضاه وسخطه.
فلسفة أبو الطيب المتنبي في الحياة
لم يتّخذ المتنبي الفلسفة علماً يدرسه أو يختص به، ولم يكن ينتمي إلى عالم الفلاسفة. إنّما جاءت فلسفته نابعةً من تأملاته في الحياة، ومن تجاربه الشخصية، ومن ثقافته الواسعة.
يُرى أنّ المتنبي تأثر بالفلسفة اليونانية، وقد اقتبس فلسفته من فلاسفة اليونان أمثال أرسطو.
اتّسمت فلسفة المتنبي بالقوة، فتجلّت هذه القوة في شعره في موضوعاتٍ مختلفة، أهمها:
ذم الدهر والناس
نظر المتنبي للدّهر والنّاس نظرة المتشائم، فكان يرى أنّ الدّهر يقف حائلاً بينه وبين تحقيق آماله وطموحاته، وأنه لا وجود لنعيمٌ دائمٌ ولا شقاءٌ دائمٌ، وأنّ الحياة يسرٌ وعسر.
قال معبراً عن ذلك:
صَحِبَ الناسُ قَبلَنا ذا الزَمان
وَعَناهُمْ مِن شَأنِهِ ما عَنان
وَتَوَلَّوا بِغُصَّةٍ كُلُّهُم مِنــهُ
وَإِن سَرَّ بَعضُهُمْ أَحيان
رأى أنّ الناس سبب شقائه، لا سيما الملوك والأمراء الذين وعدوه وأخلفوا في وعودهم. وقال ذاماً للناس:
ودَهْرٌ ناسُهُ ناسٌ صِغار
وإنْ كانتْ لهمْ جُثَثٌ ضِخامُ
أرانِبُ غَيرَ أنّهُمُ مُلُوكٌ
مُفَتَّحَةٌ عُيُونُهُمُ نِيَامُ
فلسفة الموت والحياة
أقرَّ المتنبي أنّ الموت قدرٌ محتومٌ لا بدّ أن يطال كل إنسانٍ، وأنه لا محالة آتٍ. فضّل الموت على حياة الذل والمهانةِ، ورأى أنّ على الإنسان أن يعيش حياته عزيزاً قوياً طموحاً ساعياً نحو الرفعة والسّمو، وأنْ يحارب ويناضل في سبيل ذلك.
قال معبراً عن ذلك:
إذا غامرتَ في شرفٍ مَرومٍ
فلا تَقْنع بما دونَ النجومِ
وقال مؤكداً هذه الفلسفة في نونيته:
غيرَ أنّ الفتى يٌلاقي المَنايا
كالحاتٍ ولا يُلاقي الهَوان
وإذا لم يَكُن من الموتِ بُدٌّ
فَمِن العجزِ أن تكونَ جبان
فلسفة العلاقات الاجتماعية
كانت خيبات الأمل التي تلقاها المتنبي في حياته سبباً لافتقاده ثقته بالناس. أوصله ذلك إلى مرحلة لم يعد يرى فيها من أخلاق الناس إلّا أقبحها.
رأى أنّ الناس متقلبين لا يثبتون على مواقفهم. قال معبراً عن ذلك:
إذا ما النّاسُ جَرّبَهُمْ لَبِيبٌ
فإنّي قَدْ أكَلْتُهُمُ وَذاق
فَلَمْ أرَ وُدّهُمْ إلاّ خِداعاً
وَلم أرَ دينَهُمْ إلاّ نِفَاقَ
فلسفة الشجاعة والعقل
رغم إيمان المتنبي بأنّ الشجاعةِ هي أساس العُلّو والمجد، إلّا أنّه كان يرى أنّ لا أهمية لها دون عقل. العقل في فلسفة المتنبي متمم للشجاعةِ، بل ومقدّم عليها، إذ إنّه يميّز الإنسان عن الحيوان.
قال في هذا المعنى:
الرّأيُ قَبلَ شَجاعةِ الشّجْعانِ
هُوَ أوّلٌ وَهيَ المَحَلُّ الثّاني
إذا همَا اجْتَمَعَا لنَفْسٍ حُرّةٍ
بَلَغَتْ مِنَ العَلْياءِ كلّ مكانِ
الأغراض الشعرية في شعر المتنبي
تنوّعت الأغراض الشعرية في شعر المتنبي، فقد نظم قصائد في المديح، والرثاء، والهجاء، والغزل، والعتاب والشكوى، والفخر، والوصف، تفاوتت في عددها.
استحوذ المدح على معظم قصائد ديوانه، إذ شكلت قصائد المدح أكثر من ثلث الديوان.
وفيما يأتي شرحاً مفصلاً عن كل غرض من هذه الأغراض:
المديح
مدح أبو الطيب أكثر من خمسين شخصاً كان أكثرهم من الأمراء، والوُلاة، وقادة الجيوش. أمّا بعضهم الآخر فكان من أواسط الناس. لكنّ أكثر مدائحه كانت لسيف الدولة الحمدانيّ، و بدر بن عمار، وكافور الإخشيدي، وأبي العشائر، وعضد الدولة البويهي، وأبو شجاع فاتك.
اتّسمت معاني المدح عند المتنبي بالغزارة والقوة.
لم يتخلّ المتنبي في مدائحه عن شخصيته ولا عن اعتزازه بنفسه، كما اتّسمت مدائحه أيضاً بالمبالغة وكثرة المحسنات البديعية.
ومن الأمثلة على تلك المدائح هذه الأبيات التي قالها مادحاً كافور الإخشيدي:
يُدِلّ بمَعنىً وَاحِدٍ كُلُّ فَاخِرٍ
وَقد جَمَعَ الرّحْمنُ فيكَ المَعَانِيَا
إذا كَسَبَ النّاسُ المَعَاليَ بالنّدَى
فإنّكَ تُعطي في نَداكَ المَعَالِيَا
الهجاء
لم ينظم المتنبي الكثير من شعر الهجاء. لم يهجُ إلّا ناقماً وكارهاً.
ومن ذلك هجاءه لكافور الإخشيدي لأنّه خيّب أمله ورجاءه، وهجاءه لابن كَيغَلَغ الذي رامَ المدح فما حصّل إلا الهجاء.
جاء هجاء المتنبي لاذعاً شنيعاً موجعاً ومحققاً لهدفه، كسخريته من كافور حينما قال:
وَتُعجِبُني رِجْلاكَ في النّعلِ، إنّن
رَأيتُكَ ذا نَعْلٍ إذا كنتَ حَافِيَ
وَإنّكَ لا تَدْري ألَوْنُكَ أسْوَدٌ
من الجهلِ أمْ قد صارَ أبيضَ صافِيَ
لم يقتصر هجاء المتنبي على الأشخاص إنما تعدّاه إلى هجاء الزمان والناس. ومن ذلك ما قال فيهما:
ما كُنتُ أحْسَبُني أحْيَا إلى زَمَنٍ
يُسِيءُ بي فيهِ عَبْدٌ وَهْوَ مَحْمُودُ
ولا تَوَهّمْتُ أنّ النّاسَ قَدْ فُقِدوا
وَأنّ مِثْلَ أبي البَيْضاءِ مَوْجودُ
الفخر
امتُلئ شعر أبو الطيب بفخره بذاته. لا تكاد تجد قصيدة من قصائده تخلو من ذلك، فهو يفتخر بنفسه في المدح، وفي الهجاء، وحتى في الرثاء.
يُرجّح أنّه كان يُشعر بتفوقه على الناس، وذكائه وطموحه وشجاعته وصبره، بالإضافةً إلى ظروف حياته القاسية، وكثرة أعدائه ومنافسيه في مجالس الأمراء.
قال مفتخراً بطموحه وقوة إرادته:
أُريدُ مِنْ زَمَني ذا أنْ يُبَلّغَن
مَا لَيسَ يبْلُغُهُ من نَفسِهِ الزّمَنُ
وقال مفتخراً بشجاعته وفروسيته:
لأترُكَنّ وُجوهَ الخَيْلِ ساهِمَةً
وَالحرْبُ أقوَمُ مِن ساقٍ على قَدَمِ
والطّعْنُ يُحرِقُها وَالزّجرُ يُقلِقُها
حتى كأنّ بها ضَرْباً مِنَ اللَّمَمِ
أمّا في تحمّله لنوائب الحياة وصموده أمام أحداث الدهر فقال:
ألدّهْرُ يَعْجَبُ من حَمْلي نَوَائِبَهُ
وَصَبرِ نَفْسِي